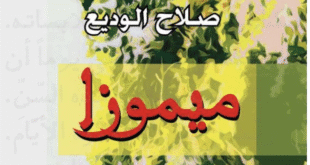مقدمة
تعدّ الرواية العربية الحديثة التي تندرج تحت مسمى “الرواية الأطروحة” أو “رواية السجون” -والتي كان من أبرز روادها الروائي عبد الرحمن منيف- من النصوص السردية التي شغلت الدرس النقدي المهتم بقضايا السرد بصفة عامة، وقضايا الأيديولوجيات والحرية والواقع والخيال وغيرها من اهتمامات النقد المعاصر. بيد أن الرواية المهتمة بتصوير الصراع بين المثقف والسلطة، لها نمط تجريبيّ خاص، وخصوصية سردية تنحو منحى الاستشراف لصور سردية جديدة تفيد من الأجناس الأدبية الأخرى. من هذا المنظور، تتناول الدراسة الرواية السجنية من خلال رواية “تلك العتمة الباهرة” للروائي المغربي الطاهر بن جلون. حيث ركّزت على عنصر الزمن السردي في هذا النوع الروائي الذي يتعالق فيه الزمن النفسي والفلسفي؛ قصد الكشف عن كون هذا التعالق الزمني يساهم في بناء نوع من التشكيل البنيوي لتقنيات الزمن من حيث حركات التواتر والترتيب، من خلال تعالقها بالأزمنة النفسية والفلسفية. لتصل الدراسة إلى صوغ عام يكون فيه الزمن السردي فاعلًا في تصوير الحدث، وتصوير الانفعال وأيديولوجيا الكتابة عامة. ما مكّن من الإجابة عن الإشكالية الآتية: كيف تعامل الروائيّ الطاهر بن جلون مع بنية الزمن في روايته؟ هل كانت بنية الزمن في النص بنيةً دالةً أم اتخذت بعدًا جماليًا فقط؟
أولًا: الروية السجنيّة، وهاجس الحرية
لا شك أنّ تجربة السّجن السياسيّ تجربة إنسانيّة بالغة الرهافة والخصوصيّة. تجترح الذّات، وتحفر عميقًا في ثنايا الروح ما لا يُنسى بما تثيره من أسئلة، أو تشي به من دلالات، أو تحتمي به من قناعات. وليس السجن السياسيّ إلاّ مظهرًا من مظاهر غياب الديمقراطية، واستشراء ظاهرة القمع السلطويّ القاهرة، الذي يصادر حرية المرء، ويمتهن كرامته، ويضيّق عليه الخناق. إنه “الوجه الماديّ للقمع، أو هو القمع المعلَن. حين تمارس السلطة قمعًا آخر غير علنيّ في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة من خلال مؤسساتها ودوائرها وشركاتها، ومن خلال بيروقراطيتها المنظورة وغير المنظورة على حد سواء”(). لهذا، سعت الرِّواية العربيّة للبحث عن معنى الحريّة وقيمتها في عالم يمور بالفوضى، ويعجّ بمختلف أصناف القهر والاستبداد. ما مكنها من تأكيد حضورها النوعيّ في مواجهة أوجه القمع المختلفة بإطلاق سراح المقموع والمسكوت عنه، و”ضبط إيقاع الصوت المائز لهموم الزّمن الخاص بالواقع وسط إيقاعات الأصوات المتنافرة لأزمنة العالم الذي تحوّل إلى قرية كونيّة فعلًا، لكنّها عبارة عن قرية يختلط فيها الحلم بالكابوس، ويمتزج فيها الوعد بالوعيد”(). حاولت رواية السّجن السياسيّ إعادة بناء عالم السّجون حياتيًا وروائيًا في أبنية سرديّة عدّة، صوّرت مراحل الملاحَقة والتّرويع، والاعتقال والاستنطاق، والتّحقيق واختلاق التُهَم، وانتزاع الاعترافات والتّعذيب حدّ الموت، حتّى غدت دلالة على قمع الدولة التّسلطيّة”().
ربما من أهمّ أسباب اهتمام الرواية العربيّة بالتّعبير عن ظاهرة أساسيّة من ظواهر الرِّواية العربيّة في تمرّدها الإبداعيّ في تجربة السجن السياسي، واتخاذها موضوعًا روائيًا: نزوع الأدب بطبيعته إلى الحريّة، ورغبة المبدع في تحدي القامع، ومجابهته مُسلحًا بالكلمة()؛ بعد أنْ غالت النُظُم المستبدّة في خرق حقوق الإنسان؛ فالأنظمة الدكتاتوريّة “مهما بدت قويةً ومسيطرةً فإنّها ذات أرجل طينيّة، وتحمل بذرة فنائها في داخلها”(). تحاول روايات السّجن السياسيّ تصوير أبرز مظاهر أزمة الحريّة المُتمثِّلة في ممارسة العنف السياسيّ، والاغتراب النفسي، والرّقابة والاستبداد والمطاردة، والتّفنن في صنوف التّعذيب اللا إنساني، وتعمد إلى إدانة أساليب القمع السلطويّ، ورسم سُبل الخروج من عتمة المعتقلات المظلمة بالكلمات التي صارت بديلًا من الموت. ولأن الرواية تجربة وسؤال متجدد إبداعًا ومادةً وتلقيًا، وفي أعماق كلّ تجربة أكثر من إشارة استفهام”()، فقد اتخذت رواية السّجن السياسيّ في مقاومة تجليات القمع صورًا تعبيريّةً شتّى توزّعت بين الطّابع السير ذاتي أو الوثائقيّ، وهي أقرب ما تكون إلى الشّهادات أو المذكرات أو اليوميات كـ (أبو زعبل) لإلهام سيف النّصر 1975 ، و(الأقدام العارية) لطاهر عبد الحكيم، وثلاثيّة شريف حتاتة: (العين ذات الجفن المعدنيّة) 1978، و(جناحان للريح) 1974، و(الهزيمة) 1978، وبين الطّابع الفنيّ التّخييليّ كـ(القلعة الخامسة) لفاضل العزاوي التي زامنت في صدورها رواية (السّجن) لنبيل سليمان 1962، و(ملف الحادثة 67) لإسماعيل فهد إسماعيل 1974، و(نجمة أغسطس) لصنع الله إبراهيم 1974، و(الكرنك) لنجيب محفوظ 1974، و(شرق المتوسط) لبعد الرحمن منيف 1975، و(الآن هنا، أو شرق المتوسط مرّة أُخرى) 1991، و(الروائيّون) لغالب هلسا 1988، وغيرها من الأعمال الروائية. لهذا، غدت رواية السّجن السياسيّ نوعًا من أنواع المقاومة، ووجهًا من وجوه الاحتجاج، وأفقًا تجريبيّ المبنى والمعنى في كشف المستور، وفضح المُغيَّب، وتحرير المقموع. فقد قوّضت بما تمارسه من سردٍ فنيٍ جدران الأقبية والزنزانات المعتمة التي تئد الفكر، وتصادر الحق، والحريات. قصد تأكيد حقّ المُهمّشين والمقموعين في الحريّة، ودورهم في تحقيقها.
ثانيًا: سنوات الجمر والرّصاص، والرواية السجنية المغربية
نهضت رواية السّجن السياسيّ المغربيّة الجديدة بعبء التّعبير عن حدّة مختلف الأزمات المصيريّة السياسيّة التي عصفت البلاد. وذلك من خلال إبراز تجليات العنف الذي يعيد نفسه من خلال صور شتّى لا تهدد الذّات الإنسانيّة إلا بالعدميّة والموت والذّوبان. فقد استحضرت جحيم الزنزانات المغلقة، وفصّلت مشاهد التّرويع والحجر والتّعذيب الراعبة، وفضحت ممارسات القمع السلطويّ المدمِّرة في انتهاكها الكليّ لأبسط القيم الإنسانيّة، وأدانت سنوات العتمة والضياع التي سامت ضحاياها الخسف، وألقت مصائرهم إلى المجهول. تعدّ سنوات الجمر والرّصاص() أقرب الشّهادات على واقع سياسيّ مهترئ البنى، كوّن القمع وأفرزه ولوّنه، ومدّه إلى أن بلغ حدّ الانفصام اللامعقول في امتهان آدمية ضحاياه. ما دفع الرِّواية المغربيّة إلى اتخاذ السّلطة محورًا من محاور اشتغالاتها. لتعكس “مُتخيلًا ثقافيًا واجتماعيًا وتاريخيًا عامًا بُني خلال قرون عديدة. ويبدأ الجزء الأساس من هذا المُتخيل منذ التربية الأولى للمواطن العربيّ، والذي بمقتضاه يعدّ الحاكم ظلّ الله على الأرض(). لهذا، ارتفعت في المغرب وتيرة نشر عدد كبير من الشّهادات والمحكيّات الروائيّة والسّير الذّاتية السّجنيّة التي تقاسمتها “عدّة خصائص جماليّة ودلاليّة تتقاطع عند المنزعَين: الأدبيّ والتّسجيليّ. أمّا النّصوص التي ظهرت بعدهما فيمكن القول إنّ الطابع الإخباريّ التقريريّ قد غلب عليها، وربما كان السبب في ذلك نُضج شروط مغايرة تسمح بقول كلّ شيء مباشرةً ومن دون مواربة”(). ولعلّ من أهمّ كتابات السّجن السياسيّ المغربيّة المليئة بالحوادث والصّور والوقائع والمواقف، والمُوزّعة بين البعد التّوثيقيّ والبعد التّخييليّ: (مجنون الأمل) لعبد اللطيف اللعبي 1983، (كان وأخواتها) لعبد القادر الشاوي 1986، (المغرب من الأسود إلى الرمادي) لأبراهام السرفاتي 1998، (العريس) لصلاح الوديع 1999، (تازمامارت، الزنزانة رقم 10) لأحمد المرزوقي 2000، (درب مولاي الشريف الغرفة السوداء) لجواد أمديدش 2000، (تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم) لمحمد الرايس 2001، (سيرة الرماد) لخديجة مروازي، و(حديث العتمة) لفاطنة البيه 2001، و(تلك العتمة الباهرة) للطاهر بن جلون 2002، وغيرها من الأعمال السردية().
معتقل تازمامارت، وسلطة الفضاء
كشفت رواية الطاهر بن جلون “تلك العتمة الباهرة” وغيرها من الأعمال السردية، عتمة مدافن تازمامارت السّريّة التي أنكرتها السُّلطات المغربية في مرحلة سابقة، وأزالت النّقاب عن أبرز صور الاستبداد والاستلاب والتّشيؤ الصارخة في أقبية التّعذيب اللاإنسانية القاتمة. وتعرّي وجه زبانية الظلمة والرقابة والمطاردة المميتة. ففضاء تازمامارت لم يكن سجنًا سياسيًّا سريًا فحسب، بل كان مَدفنًا وجحيمًا وليلًا سرمديًا طويلًا، وزنزانات ضيقةً “يبلغ طولها ثلاثة أمتار وعرضها مترًا ونصف المتر، أمّا سقفها فواطئ جدًا يتراوح ارتفاعه بين مئة وخمسين، ومئة وستين سنتمترًا”(). حيث لا حياة ولا ربيع ولا عائلة، ولا أصدقاء ولا أحلام ولا أحياء ولا أسماء، ولا شيء غير الأرقام؛ فثلاثة وعشرون سجينًا في الجناح (ب)، كلُّ سجين منهم عبارة عن رقم في قبرٍ/ زنزانة، وفي كلّ زنزانة ثقبان محفوران: واحدٌ في الأرضية لقضاء الحاجة، وآخر فوق باب الحديد لإدخال الهواء(). في تازمامارت لم تكن لديهم أَسرّة ولا حتّى رقعة من الإسفنج بمنزلة فراش، ولا حتّى كومة من القش أو ورق الحلفاء التي تربض عليها البهائم، كانت لكلّ واحدٍ بطانيتان رماديتان خفيفتان مسمومتان بمحلول مُعقم، وخمسة لترات من الماء القذر غير الصالح للشرب يوميًا()، وكذا قهوة رديئة بطعم منقوع الجوارب الكريه، وحصّة من الخبز الأبيض الشبيه بحجر الكلس الذي لا يمكن قطعه ولا حتّى كسره، وعصيدة نشويات مطبوخة بالماء بلا بهارات ولا زيت()، كما كانت لديهم الأمراض التي تتهدّدهم، والأوجاع التي تمضّهم، والعقارب السّامة التي يتعمّد الحارس إطلاقها؛ لتقتلهم بصمت عقابًا لهم فضلًا عن مختلف صنوف الأذى والتّرويع السلطويّ التي تعرضوا لها على أيدي سجّانيهم المُكلّفين بتنفيذ أوامر الضابط/ قائد المعسكر)، وشتّى طرائق الاستفزاز والإرهاب الصادمة؛ يوكّد السارد هذا بعد ما قام حارسا السّجن -بأمر من الضابط- بإدخاله في جُراب واسع مصنوع من مادة متينة، وجرجرته تجاه الباب الخارجيّ؛ ليحفر قبره بيديه، فيقول: “لقد أُعطِيَت لهم الصّلاحية المطلقة في التّصرف معنا وبنا، فما الذي يحول دون عودتهم مجددًا لاقتياد واحد آخر منّا، والتّظاهر بأنّهم يهمّون بتصفيته أو رميه في حفرة ما، أو تعريضه لعقوبة الثبات، إذ يُطمَر الجسم بأكمله مقيّد اليدين والقدمين، ما عدا الرأس الذي يبقى بارزًا سوية الأرض معرَّضًا لشمس الصيف أو مطر الشتاء، ربما كان لسجّانينا لائحة عُدّدت فيها طرائق سوء المعاملة التي ينبغي لهم أنْ يخضعونا لها بحسب أمزجتهم”(). ذلك أن السّجن هو المكان السّيد، والمُتسيّد البطل الذي “يُعيد صوغ الآخر ليس بطبوغرافيته فقط، ولكن بأنظمته وقوانينه وعالمه الكليّ الخاص؛ لأنّ الآخر هنا فاقد الحريّة وهو متلقٍ فحسب”(). إن السّجن بهذا المعنى “لا يكفّ عن كونه ذا أبعاد ومقاسات تميّز انغلاقه ومحدوديته، ويتحوّل إلى فضاء مخصوص ينهض على أنقاض العالم الخارجي المألوف().
الرواية السجنية بوصفها شهادة تاريخية
تشغل الحريّة فكر الروائيّ المغربيّ الطّاهر بن جلون(). وتلحّ عليه، وتُعبّر عن نفسها في أعماله الأدبيّة الروائيّة بوسائل فنيّة شتّى، تتمرّد شكلًا ومضمونًا على آليات القمع؛ لتصير أداةً من أدوات الفعل والتأثير، ووجهًا من وجوه المقاومة. ويوكّد بن جلون في ظلّ تنامي سطوة القهر على أهمية الدّفاع عن الحريّة المسؤولة، وليست حرية الفوضى، واحترام الشّخص بوصفه شخصًا لا كرُكْنٍ في شيءٍ مُجرّدٍ من الواقع، مؤمنًا بأنّ وظيفة الإبداع “تكمن في تجاوزه للواقع السائد الملموس، وهو شرط ضروريّ ليكون الإنسان كائنًا مُتضادًا، يقاوم الذّوبان في المؤسسات القائمة والنّظام السائد(). تستلهم رواية (تلك العتمة الباهرة) شهادة (عزيز بنبين) أحد معتقلي سجن تزمامارت() الرهيب على سنوات الظلمة والوجع، والقهر والانسحاق تحت وطأة السّلطة القامعة التي تتربّص بالإنسان، وتصادر وجوده، وتتهدّده حدّ الذّوبان. حيث تروي الرِّواية مأساة مجموعة من تلامذة مدرسة اهرمومو العسكريين، الذين تورّطوا على أيدي قادتهم العسكريين الكبار في ما سُمّي بـ (محاولة انقلاب قصر الصخيرات الملكي) عام 1971. على الرغم من أن تلك المعلومة التي خرجوا من أجلها كانت بهدف المشاركة في مناورة عسكريّة فحسب، وتقصّ رحلة عذابهم اللامتناهي بعد زجّهم أحياء في قبور تزمامارت التي كان الموت فيها رفاهيةً لا يستحقونها إلاّ مرضًا أو جوعًا أو جنونًا، أو انتحارًا.
الرواية السجنية والسارد الشاهد
يهيمن على رِواية “تلك العتمة الباهرة” الأسى والألم، وتتوشّح سوادًا على امتداد فصولها(). لترسم للقمع صورًا فجائعيّة غرائبيّة صادمة في لا إنسانيتها الطاغية؛ فالمرئيات في الحفرة غائمة، والآمال بعيدة ذاوية، والجراح فاغرة، والموت بطيء، ومسلسل العذاب طويل الحلقات هنا “في باطن الأرض الرطبة المفعمة برائحة الإنسان المُفرغ من إنسانيته بضربات معزقة تسلخ جلده، وتنتزع منه البصر والصّوت والعقل”(). تكشف الرِّواية عبر ساردها الشاهد “سليم” المعاناة النّفسيّة الرهيبة للمسجونين المدفونين أحياء في القبور/ الزنزانات الضيقة، وقد كابدوا مختلف صنوف التّعذيب والاستفزاز والإرهاب، مجرَّدين من كلّ ما قد يشي بإنسانيتهم في رحلتهم الصعبة مع الموت الذي انتزعهم وهم أحياء من حياتهم. يسرد السارد الشاهد/ السجين سليم، بعض فصول معاناتهم في رحلتهم إلى الموت معصوبي الأعين، مكبلي الأيدي، بعد أنْ قضوا الأشهر الأولى في سجن القنيطرة السياسيّ المريع، والمعروف بصرامة قوانينه وغلظة حراسه، والذي بدا لهم – في ما بعد- “سجنًا يُشبه أنْ يكون بشريًا، فهناك نور السماء وبصيص الأمل”()، إذا ما قُورِن بمعتقل تزمامارت المؤبد الذي “شُيِّد كي يبقى إلى الأبد غارقًا في الظلمات”(). تقدّم رواية “تلك العتمة الباهرة” صورة تزمامارت الجهنميّة بطريقةٍ فنيّةٍ. تجعل منه بؤرة السرد المركزيّة التي تساهم في صنع الحدث وتشكيله وتناميه، وقاعدة محوريّة تشدّ مختلف عناصر البناء الروائيّ إليها، ورمزا مهمًا من رموز البحث الدائب عن الحرية المُصادَرة في ظلّ آليات القمع الجائرة التي لا تُفضي إلاّ إلى الخيبة والخواء والصمت. بهذا، يُحمِّل السارد/ الروائي الطاهر بن جلون زنزانات تزمامارت ومدافنها أبعادًا سياسيّةً واجتماعيّةً ونفسيّةً. تمنح العمل الروائي خصوصيّته بوصفها مُكونًا من مُكونات النّص الفنيّة التي تذوب فيه الرؤية، وتتضافر مع لُحمته وسداه. والحال أنّ المكان “لا يعيش منعزلًا عن باقي عناصر السّرد، وإنما يدخل في علاقات متعدّدة مع المُكونات الحكائيّة الأخرى للسّرد (الشّخصيات والحوادث والرؤى السّرديّة)، وعدم النّظر إليه ضمن هذه العلاقات والصّلات التي يقيمها، يجعل من العسير فهم الدور النّصي الذي ينهض به داخل السرد”(). لهذا، تُبرِز الرِّواية مدى اعتناء الروائي الطاهر بن جلون بتشكيل صور المكان واقعًا وتخييلًا مستغلًا طاقاته كلها في تجسيدها وتحميلها بحمولات دلاليّة عدّة. تعكس مختلف ألوان التّشيؤ التي لا تعترف بإنسانيّة الشّخصيّة منذ تجريدها من هُويّتها الخاصّة، وانتزاع اسمها، واستبداله برقم ضائع. يجعل منها نكرة في عداد النّكرات، وحتّى موتها قهرًا وحقدًا وجنونًا؛ فالضابط الآمر الذي لم يطأ أرض المُعتقَل يومًا كان يزعق في وجوه الحراس قائلًا: إياكم أنْ تأتوا إليّ لتخبروني أنّ فلانًا مريض، لا تأتوا إلاّ لتعلموني أنّه مات، لكي تصحّ حساباتي”(). تعيد الرِّواية رسم شخصياتها وفق تشكيلها لصور المكان تلك، حيث تنقلهم من الشيء إلى نقيضه، فمن بيوتهم فوق الأرض إلى مدافنهم السّريّة تحتها ثمّة الكثير ليغيّرهم، ويعيد تكوينهم ماديًا ومعنويًا، ويباين بين مواقفهم ورؤاهم وتوجُهاتهم وطرائقهم في مواجهة الخوف الذي يشقيهم ومصارعة الموت البطيء المحكومين به إلى الأبد على النحو الذي أشرنا إليه سابقًا. فمن “خلال الشخصيات المتحركة ضمن خطوط الرواية الفنية، ومن خلال تلك العلاقات الحية التي تربط كل شخصية بأخرى، يستطيع الكاتب الإمساك بزمام عمله وتطوير الحدث من نقطة البداية حتى لحظات التنوير في العمل الروائي. لكن هذا لا يتأتى بطبيعة الحال من غير العناية وبصورة مدققة وسليمة في رسم كل شخصية وتبين أبعادها وجزئياتها”(). تستثمر رواية “تلك العتمة الباهرة” تجربة “عزيز” الذّاتية بتنوّعاتها ومكوّناتها وأمشاجها ولحظاتها الممتدّة خارج الزّمان والمكان. لتكوين عالم فنيّ مُتخيَّل، تتحكّم في تشييد معماره مُختلف البنى والأدوات الفنيّة من سرد ووصف وفضاء واسترجاع واستباق، فلا يفارق السارد مَسروده، بل يتماهى معه، فيصوغه ويسوقه، ويعيد إنتاجه في كتابة روائيّة سيريّة مُهجّنة يتقابل فيها السارد والروائيّ، ويندرجان معًا في تداخل مستمر ولا نهائي”(). حيث يُلقي الروائي مهمة السرد على عاتق “سليم”. فينهض بها لا بوصفه صوتًا مجردًا فحسب، بل شاهدًا مشاركًا، مؤثرًا ومتأثرًا؛ يشير إلى كاتب يحمل همومًا معينة، ويعيش في بيئة ثقافية وحضارية يتأثر بها ويحاول -من خلال فعل الكتابة- أن يكون له أثر فيها، وتتجه عناية السرديّة إلى هذا السارد بوصفه مُكوّنًا منتِجًا للسرد بما فيه من حوادث ووقائع، وتعنى برؤيته العالم المتخيَّل الذي يكوّنه السرد، وموقفه منه. نظرًا لاختلاف كيفيات حضوره الفنية وعلاقاته وصور تدخلاته وتشكلاته في العمل الفنيّ نفسه. حيث “تختلف طبيعة السارد وموقعه ورؤيته وصورته باختلاف الوظائف التي يقوم بها، وبالمقدار الذي تحظى به كل منها في النص. لأن هذه الوظائف هي نفسها العلامات التي تحدد نموذج السارد، وتضبط موقعه، وتصنع قوامه العقلي والجسدي والوجداني، وتتحكم في طريقة إدراكه للعالم المحيط به؛ وفي طريقة تلفظه وتعبيره عن هذا العالم”(). وتومئ الرِّواية من خلال السارد المتكلّم بضمير المتكلم/ الأنا، إلى أهمية قهر الموت بالتّشبّث بفكرة الحياة؛ فكلّما أطلّ وجه الموت المتقبِّض على السارد في استبقاء الحياة، يحدوه إحساس بالسّلام وقد تصالح مع ذاته بعد أن غمره النور الذي جابه به العتمة. لهذا، فلم تفلح ثمانية عشر عامًا مِن الشدّة في أن تنتزع منه إنسانيته. بل أفلح هو في إفراغ ذهنه من الماضي اكتفاءً باللحظة القارّة، وقمعًا لكلّ ما قد يشي بالشقاء المُرّ والوجع المقيم، مُتخطيًا مشاعر الخوف والرغبة في الثأر أو التّدمير. إذ “كلّما أمكن التّقدم في تبديد مشاعر الخوف والانتقام والغُبن بقول الحقيقة، وتسمية الأشياء توفَّر المناخ النّفسيّ والسّياسيّ الملائم أمام مُصالحة المغاربة مع أنفسهم، ومع تاريخهم، ومع بعضهم البعض”(). وهنا، تتّضح دلالات المكون اللساني (عتبة النص الرئيسة) “تلك العتمة الباهرة” السيميائيّة. فعلى الرغم من جحيم العتمة السرمديّ، ثمّة ضوء يعيد للحياة نسغها، يلوّنها بغير الأسود، ويمدّها بأسباب الخصب والنّماء مُنطلقًا من قلب عتمة القاع إلى نور روح الحريّة والانعتاق. فما زقزقات (طير ثيبيبط) أو (لفقيرة) عصفور الدُوريّ المغربيّ في كُوة تهوية زنزانة السارد “سليم”()، إلاّ بشارة من بشائر الحياة. وما تسلّل اليمامة إلى إحدى الزنزانات في غفلةٍ من الحراس()، وانتقالها بعد اتفاق السّجناء على تسمّيتها بـ”حريّة” من زنزانة إلى الأخرى، وتحميلها رسائلهم الشفويّة الممتلئة بألم البعد، والمفتوحة على الوجع تارةً، والأمل تارةً أخرى إلاّ بصيص أمل، و”مشكاة نُعمى ونور”(). فقد آنست وحدتهم، وبدّدت عتمة محنتهم العظيمة مدّة الشّهر الذي كانت بينهم قبل أنْ يُطلقوا سراحها.
ثالثًا: الزمن في الرواية الحديثة
الزمن النفسي ورواية تيار الوعي
تتباين كيفيّات حضور الزمن بوصفه “المادّة المعنويّة المجرّدة التي يتشكّل فيها إطار كلّ حياة، وحيز كلّ فعل وكلّ حركة”()، فتختلف طرائق إدراكه، وآليات بنائه وتجسيده. حيث يمثّل المكان الخليفة التي تقع فيها الحوادث في حين يمثّل الزّمن الخط الذي تسير عليه الحوادث هذه.
يرتبط الزّمن بالإدراك النّفسيّ على عكس المكان الذي يرتبط بالإدراك الحسيّ. وقد “يسقط الإدراك النّفسيّ على الأشياء المحسوسة لتوضيحها والتّعبير عنها”(). ويمثّل الزّمن محور البنية الروائيّة وجوهر تصويرها الذي يشدّ أجزاءها كما محور الحياة؛ لأنّ “الزّمن وسيط الرواية كما هو وسيط الحياة”(). حيث تستمدّ الرواية أصالتها من كفاية تعبيرها عن ذلك النمط، وإيصاله إلى القارئ، وجميع طرائق السرد وأدواته، تنتهي في التحليل الأخير إلى المعالجة التي توليها لقيم الزّمن وسلاسله، وكيف تضع الواحدة في مواجهة الأخرى”(). ويعدّ الزّمن بحركته وجريانه “المحور الأساس المميّز للنصوص السردية بشكل عام، لا بوصفها الشكل التّعبيريّ القائم على سرد حوادث تقع في الزّمن فقط، ولا لأنّها كذلك فعل تلفظيّ يُخضع الحوادث والوقائع المروية إلى توالٍ زمني، وإنّما لكونها إضافةً لهذا وذاك، تداخلًا وتفاعلًا بين مستويات زمنيّة متعددة ومختلفة. منها ما هو خارجيّ ومنها ما هو داخلي”(). لهذا، يلعب الزّمن بأبعاده: الماضية المُسترجَعة، والحاضرة القارّة، والمستقبليّة المستشرَفة دوره الوظيفيّ الفاعل في تشكيل الحوادث أو تصعيدها، ورسم أبعاد الشّخصيات وتصويرها في قلب المكان الذي ينفعل بحركة الزّمن، ويرتبط به في علائق جدليّة متشابكة توكّد دورهما في النّص، إذ لم يعد الزّمن “خيطًا وهميًا يربط الحوادث بعضها ببعض، ويؤسس لعلاقات الشّخصيات بعضها مع بعضها، ويظاهر اللغة على أن تتخذ موقعها في إطار السيرة، لكنه اغتدى أعظم من ذلك وأخطر”(). وتعني الرواية بالزمن الروائي: الطبيعي الخارجي()، والذّاتي النّفسيّ ودورهما في النّسيج الفنيّ، وأثرهما في بقية عناصر البناء، وإيقاع حركتيهما بوصفها “فنًا لشكل الزّمن بامتياز. لأنّها تستطيع أن تلتقطه وتخصّه في تجلياته المختلفة الميثولوجيّة والدائريّة والتّاريخيّة والببلوغرافية والنّفسيّة”(). يفارق الزّمن الروائيّ المُتخيّل الزّمن الواقعيّ المُتحقِّق على الرغم مما بينهما من علائق تفاعليّة(). حيث يتجاوز المُتخيّلُ الإبداعيُّ الواقعيَّ المنطقيَّ، مُنفتحًا على أزمنة عدّة “تتداخل وتتكاثف وتستغني عن استمراريّة الحركة إلى الأمام من خلال تيار الوعي ومراوحة الزمن”(). وتشكّل تقنياتُ القصّ السّرديّة، من خلال علائقها الوشيجة مع الزّمنِ، الرِّواية، وتمنحها أبعادًا فنيّة. تتجاوز الأزمنة الحقيقيّة إلى التّخييليّة، والطبيعيّة الخارجيّة إلى الذّاتية الدّاخلية، وتؤثّر المفارقات الزّمنيّة التي تنتظم النّص في حركة السّرد وإيقاعه، ودوره في العرض والتّرتيب فـ”تارة نكون إزاء سرد استذكاريّ. يتشكّل من مقاطع استرجاعيّة. تُحيل على حوادث تخرج عن حاضر النّص، لترتبط بفترة سابقة على بداية السّرد. وتارةً أخرى، نكون إزاء سرد استشرافيّ يعرض لحوادث لم يطلْها التّحقق بعد. لتغدو مجرد تطلعات سابقة لأوانها”().
يتداخل الزّمان مع المكان في رواية “تلك العتمة الباهرة”، وتتقاطع دوائرهما في كُلٍ واحدٍ “مُدرك ومُشخّص ليتكثف الزمن ويتراصّ، ويصبح شيئًا فنيًا مرئيًا، والمكان أيضًا يتكثّف فيندمج في حركة الزّمان والموضوع، بوصفه حدثًا أو جملة حوادث التاريخ”(). تتموقع رواية “تلك العتمة الباهرة” بين زمنيْن: زمن اللحظة القارّة، وزمن اللحظة الماضية التي ما زالت تحتفظ بها الذاكرة أيديولوجيًا ووجدانيًا. حيث يتغلغل الماضي في الحاضر في لحظات مُختزَلة مكثّفة موضوعيّة وذاتيّة في آنٍ، ولا سيما عندما ينقطع زمن السّرد الحاضر، لتتداعى اللحظات الماضية من خلال استخدام تقنيات تيار الوعي، أو الشعور الذي “يحاول تقديم داخلية الشّخصيّة على الورق ككلِّ فن روائيّ، والاقتراب قدر المستطاع إلى محاكاة هذه الدّاخلية اعتمادًا على ما نعرفه من علم النّفس الحديث”(). حيث تتشكّل هذه اللحظة الحاضرة السرديّة ممتدَّة الأطراف عبر الماضي وتداعياته وتستحضر الرِّواية عبر روي السّجين “سليم” تقنيات تيار الوعي بأسلوب استبطانيّ استرجاعيّ نفسيّ قوامه: التّذكر والحلم، والحوار والمناجاة. يكشف عن دواخل الشّخصيات العالقة في تزمامارت بما يضيء حاضرها، ويميط اللثام عن وجوه معاناتها وصور اصطدامها مع آليات السّلطة القامعة
هيمنة ثيمة Thema الموت والزمن النفسي في رواية “تلك العتمة الباهرة”
هيمنة ثيمة Thema الموت في رواية “تلك العتمة الباهرة”
تفوح من الرِّواية رائحة الموت على امتداد فصولها، فنقف وجهًا لوجه أمام أبشع صور الموت العدميّ التي طالت جلّ المعتقلين()؛ إذ يقدّم السارد الموت بتقنيات تصويريّة سينمائيّة في مشاهد منفصلة إن أردنا الربط بينها، “فسنخرج باشتراكها جميعًا بتجرّدها عن الإنسانيّة، وبتوظيف الجسد كمادة. كان السّجين “حميد” رقم 12 أول من غادرهم مستدعيًا موته بعد ما فقد عقله، منصرفًا إلى التمتمة بالكلمات الغامضة، جاءه الموت حين ألمّت به الرعدة، وضرب الحائط برأسه مرارًا، أطلق صرخةً متماديةً، ثم ما عاد صوته مسموعًا. أمّا السّجين “إدريس” رقم 9 فقد رفض في أيامه الأخيرة تناول الطّعام الذي كان يمضغه له السّجين “سليم” رقم 7، ويُلقِمه منه لُقيمات صغيرة متبوعة بجرعة ماء، فرقّت عظامه وعضلاته كلّها، وانغرزت أضلعه في مفاصله، وتحوّل إلى “شيءٍ غريب صغير، وفقد كلّ صفة بشريّة لشدّة ما أصابه من تشوهات”(). فإذا كان السّجين “لعربي” رقم 4 قد أعلن إضرابًا عن الطّعام، وترك نفسه بعد أنْ أصابه حرمانه من التّدخين بالجنون، حيث بلغ به نحوله في أيامه الأخيرة حدًا “ما عاد فيه يُشبه البشر، كانت عيناه جاحظتين محتقنتين، وعند ملتقى شفتيه زبد جاف، وعلى وجهه ذي العظام الناتئة سيماء الشقاء كلّه والحقد كلّه”()، فقد قضى السّجين “رشدي” رقم 23 حقدًا على الجميع بعد أنْ أفقده فضاء تزمامارت الذي دخله بلا ذنب عقله، “كان يريد أنْ يقتل الجميع: الحراس، القضاة، المحامين، الأسرة المالكة، كلّ الذين كانوا سببًا في سجنه”(). بينما مات السّجين “بابا” الصعداوي الذي أُلحِق بهم -بتهمة الخيانة وقول إنّ الصحراء ليست مغربية– مُتجمِّدًا من البرد(). أمّا السّجين “مصطفى” رقم 8 فقد مات بلدغة عقرب سامّة، فاجتمعت على جسده الميت عقارب الحفرة كلها(). في حين أنّ السّجين “موح” رقم 1 الذي كان طباخًا ماهرًا في مدرسة أهرمومو العسكريّة، بدأ يفقد رشده شيئًا فشيئًا، فيستدعي أمّه ويحادثها وقت تقديم عصيدة النّشويات والخبز اليابس، فيطعمها تخيّلًا وهو لا يأكل، إلى أنْ خارت قواه ووهن صوته مستسلمًا للموت(). وينتحر السّجين “عبد القادر” رقم 2 عندما يتوقف السارد السّجين “سليم” رقم 7 عن رواية القصص، وسرد الحكايات التي كان يقاوم بها الهلاك/ الموت؛ فقد خارت قوى “سليم” بسبب الحمى، فبُحّ صوته، وتوقف عن الحكي، فاستسلم “عبد القادر” للموت، “كان انتحارًا؛ لأنّه تقيأ دمًا، فلا بدّ مِن أنّه ابتلع أداة حادة”(). ويشنق السّجين “ماجد” رقم 6 نفسه بملابسه، وقد فقد عقله مناجيًا “موحا” الشّخصيّة التي اختلقها من وحي جنونه بداية، مُنتظِرا مَن مات من السّجناء -مِن بَع – ظنًا منه أنّهم ما ماتوا، إنما يتظاهرون بالموت، لرمي الحراس في القبور، والفرار لجلب المساعدة(). وحتّى في الموت ترصد الرواية مفارقات فجائعيّة غرائبيّة لا تدفع إلاّ إلى الشعور بالأسى والكآبة؛ فالسّجين “بوارس” رقم 13 يموت “من الإمساك بعد أن شَقّ شرجه؛ لأنه لم يستطع إخراج برازه، كان يحتبسه أو بالأحرى قوة ما في داخله كانت تمنعه من التّبرز، فيتراكم البراز يومًا بعد يوم حتّى صار صلبًا كالإسمنت”(). أمّا السّجين “عبد الله” رقم 19 فيموت من الإسهال المتواصل()، والسّجين “فلاح” رقم 14 يموت من عدم قدرته على التّبول( )، والسّجين “صبان” الذي أُلحق بهم في مطلع الثمانينيات يموت بالغرغرينة التي “انتشرت في أنحاء جسمه بسرعة كبيرة، فتتجمّع على جثته الصراصير التي كانت تتساقط كالعناقيد مجتمعة”( )، والسّجين “عبد الملك” رقم 5، يموت مسمومًا بتناوله الآلاف من بيوض الصراصير التي خالطت فُتات الخبز الذي كان يحتفظ به في جُراب بطانيته الذي خاطه بنفسه()، ويموت السّجينان “محمد” رقم1، و”عيشو” رقم 17 البربريان جراء مرض مزمن بالسّعال حتّى الاختناق(). وتظلّ رحى الموت تدور فيكتمل موت 18 سجينًا من أصل 23 واحدًا في 18 عامًا، ولا يبقى في قبور تزمامارت الأرضيّة غير خمسة سجناء هم: عاشر، وعمر، وعباس، وواكرين، والسارد سليم.
إن اللافت للانتباه في تلك العتمة الطاغية الأبديّة التّزمامارتيّة (إنْ جاز التّعبير) تسرُّب رائحة الموت إلى الأقبية من حيث يدري السجناء ولا يدرون، وتغلغل آثارها في ثنايا الروح إمحاءً وإفناءً لتطال كلّ شيء حتّى الحيوان؛ ففي صورة مضحكة مبكية في آن: يُحْكَم بالسّجن خمس سنوات على كلب عضّ جنرالًا في أثناء زيارته التّفتيشيّة للثّكنة المجاورة للمُعتَقل، ولم يكد يمضي شهر واحد حتّى جُنّ جنونه ومات، “ربما لأنّه أُصيب بداء الكَلَب، وصار نباحه مزعجًا جدًا، وما عاد أحد مِن الحراس يجرؤ على فتح باب زنزانته ليحضر له طعامه، فنفق جوعًا وإنهاكًا وتعفنت جيفته(). لكن على الرغم تكرار ثيمة Thema الموت ودورانها، إلاّ أنّ صور تمثيلها الراعبة شتّى، وتجلياتها، وطرائق تشكيلها وتجسيد حضورها كثيرة، وتشي بتباين مواقف تلك الشّخصيات الروائيّة منها؛ فالموت الأسود الفاغر فاهه، يأتي بطيئًا مُتأنيًا مُرهقًا، فيكون أقسى عليهم وأشدّ في المعاناة. لأنّ مهمّة الحراس تقضي بإطالة أَمد عذاب معتقلي الزنزانات المغلقة، وإبقائهم في حالة من الاحتضار أطول مدّة مُمكنة، لكي يتسنّى للموت أنْ “ينتشر ببُطء، وألاّ يُغفِل عضوًا أو رقعة من الجلد، أنْ يصعد من أخمص القدم حتّى أطراف الشّعر، أنْ يسري بين الثنيات، بين التّجاعيد، وأنْ ينغرز مثل إبرة بحثًا عن شريان ليودع فيه سُمّه”(). ليدرك معتقلو تزمامارت في ظل مهمة جلاديهم، أنّ الموت منحة لا يستحقونها إلاّ بعد أنْ يُساموا مختلف العذاب وقد حُكم عليهم بالموت البطيء. لهذا، يطلبونه ويستعجلونه كلّما غالى في تآمره مع جلاديهم، وتريّث في المجيء، ويستسلمون له جوعًا وحقدًا وجنونًا وهذيانًا وانتحارًا. فالسّجين “لعربي” رقم 4 -على سبيل المثال– يدعو الموت إلى الحضور بعد ما أخطأه مرارًا، وتأخر عليه؛ لأنّ فيه خلاصه، فنقرأ أنينه الخافت يهذي به، فيقول: “أريد أنْ أموت، لِمَ يُبطيء الموت في قدومه؟ مَن يوخّر مجيئه، ويمنع نزوله إليّ، وانسلاله مِن تحت باب زنزانتي؟ إنّه ذو الشاربين، الحارس الجلف، يقطع طريقه، كم هو صعب أنْ نموت حين نريد الموت، فالموت لا يبالي بي، ولكن دعوه يمر، أحسنوا وفادته؛ فهذه المرّة سوف يأخذني أنا، سوف يحررني، انتبهوا جيدًا، ولا تعيقوا حركته، إني أراه”(). ويعي السارد السّجين “سليم” رقم 7 ما يتربّص به مِن موت، ويحوم حواليه مِن خَبل، فيتجاوزه متحدّيًا العدم بقمع ذاكرته التي تذكّره بمختلف طقوس الحياة التي صُودرت منه، جزمًا منه بأنّ “مَنْ يستدعي ذكرياته يَموت”( )، متحصنًا بفكره الذي ينبغي أنْ يبقى في معزل عن جلاديه. لأنّ فيه حريته وملاذه وهروبه، فكان يقيس حجم قوته، وقدرته على المقاومة بتمرين فكره، ورياضته وحثّه على تخيّل عوالم أخرى غير ماديّة يكون فيها خلاصه وانعتاقه: بالصلاة والدعاء والتّعلّق روحانيًا بربّه تارةً، وبالقراءة واستعادة المحفوظ والمقروء الفنيّ شعرًا كان أم نثرًا تارةً أخرى. يقول: “كان العفن ينال من أجسادنا، عضوًا تلو آخر، والشيء الوحيد الذي تمكنتُ من الحفاظ عليه هو رأسي، عقلي، كنتُ أتخلى لهم عن أعضائي، ورجائي ألاّ يتمكنوا من ذهني، من حريتي، من نفحة الهواء الطلق، من البصيص الخافت في ليلي، ألوذ بدفاعاتي متغافلًا عن خطّتهم، تعلّمت أنْ أتخلى عن جسدي؛ فالجسد هو ذاك المرئي، كانوا يرونه ويستطيعون لمسه وبضْعه بنصل مُحمى بالنار، بإمكانهم تعذيبه وتجويعه وتعريضه للعقارب، للبرد المُجمِّد، غير أنّي كنتُ حريصًا على أنْ يبقى ذهني بمنأى عنهم، كان قوّتي الوحيدة، أجابه به ضراوة الجلادين بانزوائي، بعدم اكتراثي بانعدام إحساسي(). لهذا، أفلحت محاولات السجين “سليم” في إعمار فكره وإعماله، وكنس ذكريات الماضي ونفضها كلّما همّت بالاحتيال عليه، والبحث في ذاته الحاضرة عن ذاته، والخروج بهما (الفكر والذاكرة) خارج الزّمان السرمديّ والمكان اللاإنساني في تبديد مشاعر الخوف والحقد، والكراهية والرغبة في الانتقام حدّ مصالحة الموت الذي يغشى الأقبية، ويحوم حول الزنزانات إلى أن يهتدي إلى إحداها. فبعد كلّ الذين قَضوا خلال ثمانية عشر عامًا كانت قد نشأت بين “سليم” وبين ملك الموت عزرائيل ألفة من نوع خاص، “فعندما تُطلِق طيور الخَبل صياحها المشؤوم يرى “سليم” عزرائيل الذي يبعث به الله لحصاد أرواح الموتى متواضعًا، مجلببًا بالبياض، صبورًا ومطمَئنًا، كان يُخلِّف وراءه عطرًا من الجنّة، وكان ذلك أجمل بكثير من صورة الموت ذي الهيكل العظميّ حامل المنجل الكبير”(). ترسم نهاية رواية “تلك العتمة الباهرة” كيفيّة مغادرة السّجناء جحيم تزمامارت سنة 1991، بعد تسرّب خبر وجوده إلى منظمات حقوق الإنسان العالميّة، عن طريق قصاصات الورق التي وفّرها الحارس “مفاضل” لقريبه البربري السّجين “واكرين” وكتب فيها السارد شيئًا عن مكانهم: “نحن في تزمامارت، لا نور”(). فقد أفلحت منظمات حقوق الإنسان والصحافة الأجنبيّة في فضح حقيقة المُعتقَل، والضغط على السلطات المغربيّة لإطلاق سراح مَنْ تبقّى مِن السّجناء في قيد الحياة، على الرغم من تعنّت هذه السُّلطات ومغالاتها في إنكار حقيقة وجود هذا المُعتقَل السّريّ، ودفاعاتها المُستميتة في محو آثار زنزاناته وأقبيته بعد أنْ سُوّيت بالأرض وكأنّها لم تكنْ أصلًا. لعلّ في محاولات السُّلطات القامعة تشويه وجه الحقيقة السّافرة ما يوكّد أنّ “ما أفظع من الفظاعة التي مورست: نفي وقوعها”( ). لم يقتصر سارد رواية “تلك العتمة الباهرة” على عرض العوالم الداخلية للشخصية الروائية، والكشف عن مكنوناتها النفسية، وما يتصارع في ذهنها من أفكار وهواجس ورغبات على توظيف أساليب اللفظ، إنما تعدى ذلك التوظيف إلى أساليب ما دون اللفظ، شأن الأسلوب الذهني الذي يصاغ بملفوظات تقع خارج لفظ الشخصية، وصوتها ومنطوقها الخاص المباشر. وتشير أساليب ما دون اللفظ إلى مستوى وعي الشخصية ومستويَي لا وعيها وما دون وعيها، بحسب ما أشار إليه فرويد Freud في “تصويره لمستوى الوعي في مرحلة أو مستوى ما قبل الكلام بشكل يجعل مستوى الوعي يقع تحت المستويين الآخرين”. حيث يأتي توظيف أساليب (ما دون اللفظ) في الرواية الحديثة مكملًا للدور البارز الذي تقوم به (أساليب اللفظ) في البوح عن العالم الداخلي، والكشف عن المستوى الذهني والنفسي للشخصية الروائية. حيث يكون لكل منهما (اللفظ، وما دون اللفظ) وأساليبهما وجوده المستقل. ففي أساليب “ما دون اللفظ”، يبنى النص الروائي على شيء من المسحة الدرامية. يتقمص فيها السارد دور الشخصية كما هو الشأن في الأسلوب الذهني Mental Style، ويتقنع بها، ويصبح هو صاحب الصوت الوحيد الذي ينطق بأفكارها ويصوغ أحلامها وحالاتها النفسية والذهنية المضطربة من دون الرجوع إلى لفظها المباشر ونطقها الخاص. فتأتي أساليب “ما دون اللفظ” ومنها الأسلوب الذهني بوصفها “أحد أساليب تمثيل فكر الشخصية التي تبرز المحتوى غير الشفاهي أي غير اللفظي للشخصية الروائية، ولا سيما الشخصيات المتخلفة عقليًا فيصاغ الخطاب عبر مستويات لا وعيها وما دون وعيها”().
يعد الأسلوب الذهني وما يعتمده من حالات نفسية وذهنية (الأحلام، وأحلام اليقظة، والهستيريا والهذيان والذهول العقلي …إلخ) من أبرز أساليب ما دون اللفظ التي لا ترتكز على لفظ الشخصية ونطقها الخاص المباشر، ولا تؤشر في صوغها على وجود أي سمة ذاتية أو تعبيرية تدل على ذلك التلفظ كما في (المونولوج غير المباشر). ارتبط هذا الأسلوب في الدراسات النقدية الغربية الحديثة بالناقد روجيه فايول الذي وصفه أنه: “عرض لساني مميز للذات الذهنية لشخصية ما، إذ يحلل هذا الأسلوب الحياة الذهنية للشخصية، ويقف على المظاهر الأساس في محتواها الذهني، ويسعى لخلق صوغٍ دراميٍ لنظام وبنية أفكارها الواعية واللاواعية، وعرض كل ما تتأمله الشخصية، وما يضمه ذهنها من انشغالات وآراء وقيم ومنظورات خاصة تؤثر بشدة في رؤية الشخصية للعالم من حولها، قد لا تكون على وعي بها”().
إذ وجد فايول Fayolle في هذا الأسلوب صوغًا دراميًا لمحتويات ذهنية وهواجس وأفكار وتصورات، وإرهاصات فكرية قامعة في ذهن الشخصية منها ما يقع ضمن حيز مستوى الوعي، ومنها ما يتعداه إلى مستوى اللاوعي، ولقد قربه ذلك الصوغ من مصطلح آخر اعتمد الصوغ الدرامي، وارتكز عليه للنطق بفكر الشخصية، وعرض ما يعتريها من أفكار وهواجس وتأزمات الأوضاع لبناء مشاهد الموت، وهو مصطلح (دراما الذهن) الذي أوجده الناقد الإنكليزي بيرسي لوبوك().
الزّمن النّفسيّ في رواية “تلك العتمة الباهرة”
تقوم رواية “تلك العتمة الباهرة” على تشكيل فني للزّمن النّفسيّ بنائيًا ودلاليًا بما تمتاز به من خصوصيّة فنيّة إيحائيّة، توكّد مدى وعي الشّخصيّة بنفسها وزمنها الدّاخليّ الخاص بصور ماضيها، وتداعياته المُتجاوزة خطّ الزّمن المنطقيّ التراتبيّ وذلك “وفق طريقة التّكنيك الزّمنيّ والسّرديّ والحدثيّ في الرِّواية”(). ذلك أن الزّمن النّفسيّ في الرِّواية زمن ذاتيّ خاص لا تحكمه معايير الزّمن الموضوعيّة الخارجيّة؛ إذ “يسير بخطىً مختلفة تبعًا لاختلاف الأشخاص، وفي الواقع في مناسبات مختلفة للشّخص الواحد؛ لأنّ الفرد يحمل المكان والزّمان معه كطرق إدراكه الحسيّ، فهناك الذين يمشي معهم الزّمن، والذين نحبّ معهم الزّمن، والذين يعدو معهم الزّمن، والذين يقف معهم ساكنًا”(). ولا يُقاس الزّمن النّفسيّ بزمن الساعة بل يُقاس بالحالة الشعوريّة، واللحظة النّفسيّة للشخصية. إنّه “زمن نسبيّ داخليّ يُقدَّر بقيم متغيرة باستمرار بعكس الزّمن الخارجيّ الذي يُقاس بمعايير ثابتة”(). ولا توجد لحظة فيه تساوي الأخرى، “فهناك اللحظة المشرقة المليئة بالنّشوة التي تحتوي على أقدار العمر كلّه، وهناك السنوات الطويلة الخاوية التي تمرّ فارغة كأنّها عدم”(). كما يعدّ زمن الشخصية الروائيّة الذي يعكس حركة الشخصية النفسيّة وعلاقتها بحاضرها وماضيها مستوىً ثانٍ من مستويات الزّمن الروائيّ كوْن زمن السرد وعلاقته بزمن الحكاية هو المستوى الأوّل، وبهذا فإنّ لكلٍ منّا زمنًا ذاتيًا خاصًا لا يسير على وتيرة واحدة بل تتغير سرعته تبعًا لإيقاع واقعنا النّفسيّ الذي “يركض عندما يكون غنيًا حافلًا فيكرّ معه الزّمان، ويحبو عندما يكون فقيرًا مجدبًا، فيزحف معه الزّمان الذي هو حبل يتجاذب به الحزن والفرح والقلب البشريّ”(). تعتمد رواية الذّات/ رواية تيار الوعي في ترتيبها الزّمنيّ شقين، هما: السّوابق الزّمنيّة للحظة السّرد الآنية، واللواحق الزّمنيّة التي تستبق اللحظة الآنية؛ ذلك لأنّنا في حياتنا اليوميّة نكون دومًا إزاء نقطتين رئيستين: الأولى هي الآن أو اللحظة الحاليّة، وأمّا الأُخرى فهي شعورنا بجريان الزّمن، وتدفّقه من الماضي إلى المستقبل()، فيُمكن في لحظة واحدة آنية أن تمتلك الشّخصيّة عدّة أزمنة، وعدّة حيوات. ويتجلّى حضور الاسترجاع الذي يتحايل به السارد على التّسلسل الزّمنيّ التّعاقبي في الرِّواية، إذ ينقطع زمن السّرد الحاضر مرارًا لاستدعاء الماضي وتوظيفه واستثماره وفق معطيات السرد الملتفّ حول تجربة الذّات. لأنّ “الشّخصيات التي تعيش أمامنا يكوّن ماضيها حاضرها”(). لكن يغْلُب الاسترجاع الماضويّ على الاستباق الاستشرافيّ في مروي السارد المشارك “سليم”. إذ يتوسّل به في تقديم الحدث والشّخصيّة والمكان، والتّعبير عن الزّمن النّفسيّ وتمظهراته بوصفه أكثر تقنيات السّرد الزّمنية قدرةً على الكشف والاستبطان. يمثّل هذا الانزياح أو الارتداد إلى الوراء مفارقةً زمنيّةً تعيد خلق الذّات تارةً، والزّمن تارةً أُخرى. حين يتضاءل في صورته الموضوعيّة الخارجيّة، وتصغر وحداته، ويمتد نفسيًا ذاتيًا إلى ما لا نهاية وفق الحالة الشعوريّة المتدفِّقة التي تكتنف النّص أو تكوّنه. فيبدو الزّمن في رواية تيار الوعي الشعوريّة معطىً مباشرًا في وجداننا() من جهة، و”مظهرًا نفسيًا لا ماديًا، ومُجردًا لا محسوسًا يتجسّد الوعي فيه من خلال مايتسلّط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر، لا من خلال مظهره في حدّ ذاته، فهو وعي خفي لكنّه متسلِّط، ومُجرد يتمظهر في الأشياء المجسّدة”() من جهة ثانية.
تعنى رواية “تلك العتمة الباهرة”، بتصوير أثر الزّمن النّفسيّ في الشّخصيّة وشعورها، وتجسيد الإحساس بمروره بطيئًا ثقيلًا جامدًا متماديًا تحت وطأة فنون التّعذيب اللامتناهية في جحيم تزمامارت. حيث الفراغ والصّمت والخواء والعزلة والموت. فقد تعظّم الخوف، وتنامى الاغتراب، وتلاشى الشعور بالزّمن في زنزانات التّعذيب، وغاب الإحساس بالحياة خارج الأقبية المظلمة. لهذا، تتكئ الرؤية السّرديّة في الرِّواية على الرؤية الدّاخليّة. حيث يقوم السارد بوظيفة السرد والوصف والتّصوير متأرجحًا بين زمنَين متداخلَين: أولهما آنيّ حاضر، وثانيهما ماضٍ مسترجَع عبر تداعيات الذاكرة، والعلاقة الجدلية بين الزمنين. جاء الأول محكومًا بمنظومة الزّمن الموضوعيّ ومعاييره، والثاني مُرتَهن بداخلية الذّات السّاردة التي لا تخضع لمبدأ التّعاقب الزّمنيّ. إنها “مأثرة الفن التي تستطيع أنْ تتحكّم بقانونية الزّمن الماديّ؛ لتقديم اللحظة أو الفترة المكثّفة عبر التقاط جوهرها، لا عبر الخضوع لمنظومة تتابعها اليوميّ الذي تخضع له الحياة الخارجية للناس كلهم”(). لهذا، يبدو الزّمن في الرِّواية شخصيّةً سلطويّةً مركّبةً. تتآمر مع الجلادين، وتتواطأ مع الموت؛ فالدقائق متمادية، والليالي بلا ختام، والموت بطيء، والزّمن الضائع الواقف قرون، والعدم سقوطٌ في اللاشيء، والاحتضار طويل، والسّجن مؤبّد، والعتمة أبدية، والعقاب بالندم خاصّةً متطاول حتّى قيام الساعة(). لهذا، يفقد الزّمن في الرِّواية معناه عندما تغيب المرئيات، وتنقطع الصّلات بكلّ ما له علاقة بالحياة الطبيعية. فيتلاشى إلى اللاشيء في عتمة الصّمت الكثيف. لهذا يروي السارد “سليم” الذي عانى الاختناق بما أفرزته مرارته من المِرَّة ألمه في ظلام حفرته التي وُري فيها، قائلًا: “في الظلام لا أتمكن طبعًا من الإبصار لكنّي على الأقل أخمّن الأشياء، فقد الزّمن معناه، أراه متماديًا بإفراط، وشاغله الأوحد أن يشلّ ذراعيّ ويديّ( ). يشكّل الليل والبُطء والسأم والصّمت في الرِّواية مفردات نفسيّة زمنيّة. تلقي بظلالها الثقيلة على شّخصيات الرواية ودواخلها الذّاتيّة الشعوريّة. لتتباين في ظلّها الرؤى والمواقف والاتجاهات. فليل تزمامارت سرمديٌّ أبديٌّ لا ينتهي “رطب لزج قذر دبق تفوح منه رائحة بول الرجال والجرذان، غير مرئيٍ لكنّه محسوس”(). يكتنف بثقله الأشياء ويحيق بها، وهو “مُكوِّن السّجناء ومرتعهم وعالمهم، وكسوة مقبرتهم وملحفتهم المنسوجة من غبار مُجمِّد، وفسحتهم المشغولة من أشجار سُود”()، ووليّ “عذاباتهم الماثل دائمًا؛ ليذكرهم بهشاشتهم وانسحاقهم”()، فقد “كفّ الليل عن أنْ يكون الليل، فما عاد له نهار ولا نجوم ولا قمر ولا سماء”(). لا أثر فيه لنور أو بصيص ضياء أمّا البُطء فهو ألدُّ أعدائهم في الظلمة، ذاك الذي كان يغلّف جلودهم المقرّحة فلا تلتئم إلاّ بعد وقت طويل؛ ليجعل قلوبهم خافقةً على الإيقاع العذب للموت القليل”(). و”شُبه البُطء في الرِّواية بساعة رمل عملاقة”(). كل “حبة رمل فيها برغلة في جلود السّجناء أو قطرة من دمهم، أو جرعة أوكسجين صغيرة سرعان ما تنفد كلّما انحدر الوقت نحو الغَوْر الذي دُفنوا فيه أحياء. والبُطء بذلك صنف من أصناف الموت الذي يتمادى ويتطاول ليطال كلّ ما قد يشي بإنسانية السّجناء المقهورين وآدميتهم، فينزعها بلا هوادة وكأنّها من المُحرّمات، ومثله السأم الذي يدور حولهم بلا معنى، يقرِض أجفانهم، ويجعّد جلودهم، وينغرز في أحشائهم”(). ويؤازر “الصّمت الثقيل البُطء متعانقًا مع الليل الطويل الذي لا ينجلي، فيتعدّد ويتكاثر في أنماط شتّى”(). فهناك صمتُ الليل الذي لا بدّ منه وقد تساوت النهارات وأرق الليالي، وغابت الفواصل بينهما، وصمتُ الرفيق الذي يغادر ببطء جنونًا وهذيانًا، وانسحابًا وانهزامًا، وصمتُ الحِداد، وصمت الدم الذي يجري في العروق متباطئًا، وصمتُ توقّع وجهة سير العقارب، وصمتُ الصّور التي تلحّ على الأذهان، وصمتُ الحراس الذي يعني الكلل والروتين، وصمتُ ظلّ الذّكريات المحترقة، وصمتُ السماء الضيقة الداكنة التي لا تكاد تُرى، وصمتُ غياب الحياة الباهر، أمّا الصّمت الأشدّ قسوةً، والأشدّ وطأةً؛ فكان صمتُ إيقاع الزّمن الصّامت الرتيب، وأثره في الشّخصيات المقاومة التي تحاول مجابهته وصدّه، والتّحايل عليه كي لا تقع فريسة لبراثنه من جهة، وتأثيره في الشّخصيات المأزومة التي لا تقوى على مواجهته، فتستسلم له من جهة أخرى؛ لهذا، تباينت مواقف الشّخصيات منه، وطرائق التّعامل معه. فقد استطاع السّجين “كريم” رقم 15 –مثلًا- أنْ يُوهِم رفقاءه في جحور تزمامارت المعتمة بالزّمن في تعقّب وتائره مجزأً إلى ساعات ودقائق وأيام، فأصبح رزنامة المعتقلين وبندولهم الناطق. كأنّها كانت طريقته في التّشبث بالحياة، أن يكون غائبًا في تتبّعه وتائر زمن محظور عليهم. يقول السارد: “والمفارقة أنّ كونه أصبح عبدًا للوقت قد جعله حرًا، جعله خارج أيّ مصاب، منعزلًا تمامًا في قوقعته الشفافة، مجردًا من كلّ ما يلهيه ويفقده سياق حسابه”(). وإذا كان السّجين “كريم” قد انشغل بحساب الوقت وتحديد الزّمن أو تتبّع وتائره تشبثًا بما قد يوحي بالحياة، فإن السّجين “ماجد” رقم 7 قد “جُنّ وفقد عقله وهو يردّد المواقيت من وراء كريم في هذيانٍ فريد؛ انتظارًا لدوره في اللحاق مع الملاك “موحا” الذي اختلقه جنونه بِمَن قضوا في زنزاناتهم ظلمًا وعدوانًا”(). أمّا السّارد “سليم” فقد استشعر وطأة ما يجثم فوقهم من ليل طويل. يسدّ أيّ أفق للحياة التي خلفوها وراءهم. فأخذ يراوغه تارةً، ويحاوله أخرى، ويتحايل عليه من دون أن يسقط في عتمته، غير مكترث له. يدرك السّارد منذ البداية أنّ زمنه القار/ الحاضر يفترق لا شك عن زمنه الفائت ويغايره. فما قبل تزمامارت شيء وما بعده شيء آخر. فيأخذ على نفسه عهدًا بألاّ ينظر إلى الوراء، أو يستشرف ذاته في المستقبل؛ كي لا يصاب بالجنون أو الهذيان، ومن ثم الموت، فيقول: “أدركت أنّ الزّمن لم يكن له معنىً إلاّ في حركة الكائنات والأشياء، والحال أنّنا كنّا محكومين بالسكون، وخلود الأشياء الماديّة، كنّا في حاضر جامد، ولو قُيض لواحدنا شقاءً أن يلتفت إلى الوراء أو أن يستشرف ذاته في المستقبل فمعنى ذلك أنّه يستعجل موته، إذ لا يتسع الحاضر إلا لجري وقائعه”(). يحاول السارد أنْ يتعلّم –لذلك– في عزلته وصمته كيف يطرد ذكريات الماضي المُنثالة عليه؛ ليخلق لنفسه ذاكرةً جديدةً تجبّ ما مضى، وكيف يدرّب نفسه مرارًا وتكرارًا على محاولة الحياة بأقل ما يمكن، ولم يكن الأمر سهلًا عليه أبدًا، بل كان بحسب قوله: “شاقًا، كان دُربة، عَتهًا لا بدّ منه، اختبارًا ينبغي لي اختباره بأيّ ثمن، أن تكون هناك مِن دون أن تكون هناك، أنْ يُغلِق المرء حواسه، ويسلّطها في اتجاه آخر، ويمنحها حياةً أخرى”(). لهذا، يقرّر السارد تجنبًا لشَرَك ذاكرته بحادثة الصخيرات إعمار فكره في التّفكر في كلّ ما حوله “فيستغرق -هربًا مِن ذاته إليها- في أحلام اليقظة الخصبة التي يؤثّث فيها لنفسه حياةً أخرى، وزمنًا مثاليًا مُغايرًا مُعلقًا بين أغصان شجرة سماوية”(). يسلك السارد في “عتمة حواسه المعطّلة درب الصوفية”(). ليتحرّر “جسده محلقًا بروحه في عوالم الغيب؛ وصولًا إلى عالم منير يغاير ظلمة عالمه الكئيب، وزمن مختلف في أبعاده وأشكال تجلّيه، لا يخضع لمنطق ولا قانون، ولا يسقط في العدم الوئيد مطلقًا. ويدجّن السارد الألم، ويجعله حليفًا له؛ إذْ تحمِله أوجاعه إلى ربّه -سالكا- حتّى يفنى ويغيب؛ فمن كنف تلك العتمة، كان يتبدى له الحقّ بنوره السّاطع”(). فتصير العتمة أقل عتامةً وقتامةً؛ ليَعْبُر عالمه إلى عالم آخر ينعتق فيه من الأذى، ويتخفّف فيه من ذاكرة الزّمن والجَوْر، فـ”كلّ يوم يمضي هو يوم ميت بلا أثر، بلا صوت، بلا لون”(). ويبرع السارد في مكابدة العذاب ومقاومة فناء الموت بالحكاية المُتخيّلة، ومواجهة السأم الجامد بالفكر، فيصير بإجماع رفقائه حكواتيّ الزنزانات. حيث يقطع الوقت، ويعاند الزّمن بما تسعفه به ذاكرته من مقروءات محفوظة، وتفيض به مُخيلته من حكايات، وتجود به قريحته من محفوظات إلى حدٍ صارت فيه كلماته ملاذًا للمعتقلين، مثل السّجين “عبد القادر” الذي وجد في الحكايات المسرودة، والقصص المحكيّة، والأفلام المنقولة البُرء والرّجاء والخلاص.
تنقل الرِّواية صور اغتراب الشّخصيّة عن ذاتها بعد انسلاخها من ذاكرتها، وانتزاعها من الحياة، وسحبها إلى صحراء اللاحياة/ الموت في مشاهد وصفيّة شتّى، وبلغة شفيفة موجِعة، لعلّ من أقساها شعور السّارد بضياع وجهه منذ ليلة العاشر من تموز/ يوليو 1971، وعدم قدرته على استعادته بعد ثماني عشرة سنة من العذاب في جحيم تزمامارت. فقد سُرِق منه، أو سقط منه في العدم مثلما سقطت منه أسنانه. فما لن يُنسى أبدًا ذلك الوجه الغريب الذي رآه في عيادة طبيب الأسنان في مركز الرّعاية الطبيّة للناجين من تزمامارت. حيث يروي بأسىً بليغ فجيعته التي عليه أنْ يحمل وزرها ويحتمِلها ويعتادها مِن بَعد: “سوف يبقى ذلك اليوم يومًا تاريخيًا في حياتي، ففيما كنتُ أستلقي على كرسي طبيب الأسنان المتحرّك، أبصرتُ شخصًا ما فوقي، مَنْ كان ذلك الغريب الذي يحدقُ بي؟ كنتُ أرى وجهًا معلقًا بالسقف، يكشّر حين أكشّر، يقطب حين أقطب كان يهزأ بي، لكن مَن يكون؟ كدتُ أصرخ لكنّي تمالكتُ نفسي، فمثل تلك التهيؤات مُعتادة في المعتقل، لكنّي هناك لم أكن معتقلًا، فكان عليّ أنْ أذعن لتلك البداهة المكدرة: إنّ ذلك الوجه المثلّم، المجعوك، المخطّط بالتّجاعيد والغموض، المذعور المرعب، كان وجهي أنا. وللمرّة الأولى منذ ثمانية عشر عامًا أقف قبالة صورتي، أغمضتُ عينيّ، أحسستُ بالخوف، خفتُ مِن عينيّ الزائغتين، مِن تلك النّظرة التي أفلتت بمشقة من الموت، مِن ذلك الوجه الذي شاخ وفقد سيمياء إنسانيته. حتّى الطبيب لم يُخفِ دهشته، قال لي بلطف: أتريدني أنْ أغطي هذه المرآة؟ لا، شكرًا. سيكون عليّ أنْ أعتاد هذا الوجه الذي حملته من دون أن أدرك كيف يتغير”(). إنّ رحلة الذهاب والإياب إلى جحيم تزمامارت رحلة موجعة في اقترابها من الموت أكثر من الحياة، وسقوطها في لُجّة العتمة غير المتناهية. إنّها تاريخ الذّكرى المُرّة، والسأم المميت، والقمع اللا إنساني. ومِن المفارقة المثيرة أنّ السارد “سليم” ظلّ ينوس بين تاريخي الظلمة والنُّور؛ فالعاشر من تموز/ يوليو 1971 هو تاريخ الظلمة لا النُّور الذي جَمُد فيه الزّمن وتوقّف. ممّا حدا بالسارد إلى التّدرب جيدًا على طرد ذاكرة ما قبله، ونفض صور انثيالاته، ووقف فوران تداعياتها. فقد كان ذلك التاريخ نقطة الارتكاز، نقطة الموت، ونقطة اللاعودة. في حين أنّ التاسع والعشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر 1991 هو تاريخ الانعتاق، والولادة من جديد “لعجوز ضامر قد رأى النُّور لتوه”() بعد ثماني عشرة سنة من التّلف والصّمت والعتمة. ولعلّ من الطريف أنْ نقرأ إهداء الرِّواية() التي تخصّ “رضا” صغير الناجي “عزيز بنبين” بوصفه نورَ حياة أبيه الثالثة. وكأن الروائيّ يريد الإشارة إلى أنّ الحياة لا تتوقف، والموت لا بدّ مِن أنْ يُقهر بحب الحياة ولا سيما بعد أنْ واصل الشاهد نفسه على عذابات زنزانات تزمامارت حياته، فاتحًا مع نفسه والحياة صفحات أمل ونور جديدة.
تركيب واستنتاج
تنوعت طرائق توظيف الزّمن في رواية “تلك العتمة الباهرة” للروائي الطاهر بن جلون. حيث توزعت بين الزمن الطبيعيّ الخارجيّ، والذاتي الداخلي/ النفسي. كما تباينت طرائق إدراكه ماديًا ومعنويًا/ نفسيًا بوصفه مكونًا رئيسًا في الرواية السجنية بصفة عامة. يدخل في نسيج الحياة الإنسانية. بحيث يرتبط في الرواية السجنية برواية تيار الوعي الشعوريّة على مستوى الكشف عن الجانب الجواني للشّخصيات، ومحاكاتها زمانًا ومكانًا بأسلوب الاستبطان النفسي. لكن مع عدم احتكام الزّمن النّفسيّ الخاص لمعايير الزّمن الموضوعيّة الخارجيّة، وتكسّر مساراته وانحرافها حدّ تشابكها وتعالقها مع غيرها من عناصر البناء السردي الأخرى. لكن على الرغم من ذلك تباينت مواقف الشّخصيات عند الطاهر بن جلون من حيث الزمن النفسي، فمن الهروب منه إلى الهوس به حد السقوط في عتمته، والاستسلام له عند بعض الشخصيات الروائية، ومن التلاشي فيه إلى مواجهته ومجابهته، والحيلولة دون الوقوع فريسة لبراثنه عند شخصيات أخرى. كما توسل الروائي الطاهر بن جلون في بناء عوالمه السردية بتقنيات زمنية أخرى. خاصة تقنية الاسترجاع في فض مغاليق العلاقة الجدلية بين الزمن والذات (السجين). ما يساهم في ديمومة الزّمن وتدفّق جريانه، وعدم انغلاقه بوصفه مُعطىً من معطيات الوجدان الكامن في وعي الإنسان وخبرته. لأن كلّ ما يحدث في الرِّواية، لا يتم إلاّ عبر الزّمن ومن خلاله. وإذا كان الزّمن في مختلف تجلياته عنصرًا متجدّدًا ومُتحوّلًا، فإنّ الرِّواية بنية متجدّدة مُتحوّلة تلتقط التّحولات وتجلياتها كذلك. ارتبط الزمن النفسي في هذا النص الروائي بأسلوب السرد النفسي عامةً في بعده الأسلوبي والجمالي، لأن صوغه الخطابي للحياة الداخلية للشخصية الروائية لم يأتِ مرهونًا بتلفظها (ما تنطق به فحسب)، بل صاغ ما لم تتلفظ به شخصيات رواية “تلك العتمة الباهرة” من دفق مشاعرها، ونقل ومضات أفكارها الواعية واللاواعية، وصوغ وتفسير ما يدور في دواخل الشخصية بشكل قد يفوق قدرتها على صوغ تلك الدواخل ونقلها.
قائمة المراجع
أولًا: المراجع باللغة العربية
إبراهيم، عبد الله. موسوعة السّرد العربيّ، ط2 (بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر، 2008).
أمنصور، محمد. محكي القراءة، ط1 (فاس: منشورات مجموعة الباحثين الشباب، 2007).
باختين، ميخائيل. أشكال الزّمان والمكان في الرِّواية، يوسف حلاق (مترجم)، ط1 (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1990).
بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1990).
برادة، محمد. أسئلة الرِّواية: أسئلة النّقد، ط1 (الدار البيضاء، المغرب، منشورات الرابطة، 1996).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الرِّواية العربيّة: واقع وآفاق، ط1 (بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1981).
بلقزيز، عبد الإله. السّلطة والمعارضة: المجال السياسيّ العربي المعاصر، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2007).
بن جلون، الطاهر. تلك العتمة الباهرة، بسام حجار (مترجم)، ط1 (بيروت: دار الساقي، 2002).
بوتور، ميشال. بحوث في الرواية الجديدة، فريد انطونيوس (مترجم)، ط2 (بيروت: منشورات عويدات، 1982).
حزل، عبد الرحيم. سنوات الجمر والرّصاص، ط1 (الرباط: دار جذور للنشر، 2004).
حسن، عمار علي. النّص والسّلطة والمجتمع: القيم السياسيّة في الرِّواية العربيّة، ط 1(القاهرة، مركز الدراسات السياسيّة والإستراتيجية، 2002).
ريكاردو، جان. قضايا الرواية الجديدة، صياح الجهيم (مترجم)، ط1 (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1997).
زايد، عبد الصمد. مفهوم الزّمن ودلالاته في الرِّواية العربيّة المعاصرة، ط1 (تونس: الدار العربية للكتاب، 1988).
شاهين، سمير الحاج. لحظة الأبديّة: دراسة الزّمان في أدب القرن العشرين، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1980).
الصديقي، عبد اللطيف. الزّمان أبعاده وبنيته، ط1 (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1995).
العبد الله، يحيى. الاغتراب: دراسة تحليلية لشخصيات الطّاهر بن جلون الروائيّة، ط1 (بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر، 2004).
عبد الملك، جمال. مسائل في الإبداع والتصور، ط1 (بيروت: دار الجيل، 1991).
عصفور، جابر. زمن الرِّواية، ط2 (القاهرة: الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 2000).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
مواجهة الإرهاب: قراءات في الأدب العربيّ المعاصر، ط1 (بيروت: دار الفارابي، 2003).
العمامي، محمد نجيب. الراوي في السرد العربي المعاصر: رواية الثمانينيات بتونس، ط1 (تونس: دار محمد الحامي للنشر، 2001).
غنايم، محمود. تيار الوعي في الرِّواية العربيّة الحديثة: دراسة أسلوبية، ط2 (بيروت: دار الجيل، 1993).
فرهود، كمال قاسم. موسوعة أعلام الأدب العربي في العصر الحديث، محمود عباس (مُراجع ومقدم)، مجلد1، ط3 (حيفا: دار المشرق للترجمة والطباعة، 1998).
الفيصل، سمر روحي. السّجن السياسيّ في الرِّواية العربيّة، ط2 (طرابلس- ليبيا: جروس بروس، 1994).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
معجم الروائيين العرب، ط1 (طرابلس- ليبيا، جروس بروس، 1995).
قاسم، سيزا أحمد. بناء الرِّواية: دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ط1 (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 1984).
القصراوي، مها حسن. الزّمن في الرِّواية العربيّة، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004).
لوبوك، بيرسي. صنعة الرواية، عبد الستار جواد (مترجم)، ط1 (الأردن: دار مجدلاوي، 2000).
الماضي، شكري عزيز. أنماط الرِّواية العربيّة الجديدة، سلسلة عالم المعرفة 355 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2008).
مبروك، مراد عبد الرحمن. بناء الزّمن في الرِّواية المعاصرة: رواية تيار الوعي نموذجًا، ط1 (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 1998).
مرتاض، عبد الملك. في نظرية الرِّواية: بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة 240، ط1 (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1998).
مندلاو. الزّمن والرِّواية، بكر عباس (مترجم)، إحسان عباس (مُراجع)، ط1 (بيروت: دار صادر، 1997).
منيف، عبد الرحمن. الكاتب والمنفى، ط3 (بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، 2001).
ميرهوف، هانز. الزّمن في الأدب، أسعد رزوق (مترجم)، العوضي الوكيل (مُراجع)، ط1 (القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 1972).
النابلسي، شاكر. جماليات المكان في الرِّواية العربيّة، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1994).
همفري، روبرت. تيار الوعي في الرواية الحديثة، محمود الربيعي (مترجم)، ط1 (القاهرة: دار غريب، 2000).
يقطين، سعيد. انفتاح النّص الروائيّ، ط2 (الدار البيضاء: المركز الثقافيّ، 2001).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
قضايا الرِّواية العربيّة الجديدة: الوجود والحدود، ط1 (القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيع، 2010).
ثانيًا: المراجع باللغة الفرنسية
Barthes, Roland. Introduction à l’analyse structurale du récits (in) Communications 8 (Paris: Seuil, 1981).
Fayolle, R. La critique (Paris: Arnold colin 1978).
Freud, S. Essais de psychanalyse appliqué (Paris: Gallimard, 1933).
Tadié, Jean- Yves. La critique littéraire au xx siècle (Paris: Belfond, 1987).
ثالثًا: المجلات والدوريات
برادة، محمد، “الرِّواية أفقًا للشكل والخطاب المتعدديْن”، فصول، مجلد11، عدد4، (1993).
بوطيب، عبد العالي، “إشكالية الزّمن في النّص السرديّ”، فصول، مجلد11، عدد2، (1993).
عيد، عبد الرزاق، “عطالة البناء وتخلخل البنية وانحطاط القيم”، الطريق، عدد3 و4، (1981).
محمد، نصر الدين، “الشخصية في العمل الروائي”، الفيصل، عدد37، (1980).
باحثة مغربية في مجال التراث والنقد الأدبي العربي والشؤون التربوية، شهادة الدراسات الجامعية العامة (أدب حديث)، شهادة الإجازة العليا (اللغة العربية وآدابها)، عضوة في جمعية الفوانيس المسرحية، عضوة في جمعية المنار للثقافة والتربية. من مؤلفاتها: (أمسية الغرباء “قصص”، 2002، دار القرويين، المغرب)، (طائر الموت “قصص”، 2006، مطبعة الأندلس)، (عوالم الصحراء؛ التقاليد والعادات، 2008، المغرب)، (طريق قصبات الجنوب، دراسات في التراث المادي، 2011، المغرب). نشرت دراسات ومقالات نقدية عديدة في مجلات ودوريات عربية متنوعة (مجلة البحرين الثقافية، مجلة العربي، مجلة تراث الإماراتية، مجلة الكويت، مجلة العربية والترجمة، جريدة الفنون الكويتية)، وفي جرائد ومجلات مغربية.
 أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد
أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد