السجون في مصر في العصر المملوكي
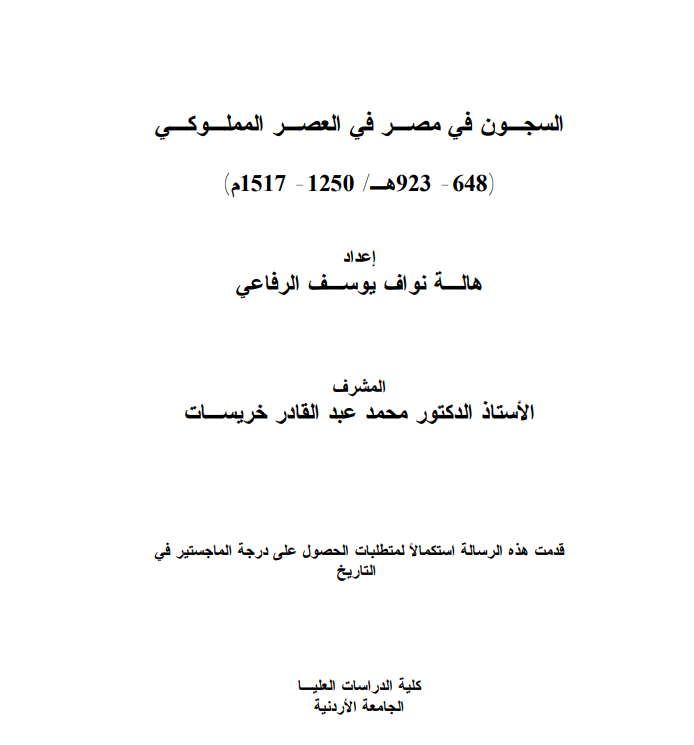
أحمد رائف هو المفكر الإسلامى والخبير الاستراتيجى فى الشئون العربية وصاحب أشهر كتاب لتوثيق التعذيب سجَّل فيه وقائع حدثت معه هو شخصياً ومع زملائه خلال الحقبة الناصرية وأطلق عليه (البوابة السوداء) وكان ينتمي الى جماعة الإخوان المسلمين ويعتبرها المدرسة التى تربى فيها. ولكن رغم ذلك فإن المرشد العام للإخوان المسملين محمد مهدي عاكف ينكر كونه من الإخوان المسلمين وذلك في حديث له لجريدة المصري اليوم في 24 أكتوبر 2009
كان رائف عضوا بجمعية الإخوان المسلمين والتي كانت وقتها نادي إجتماعي ولم يكن ينتمي تنظيميا للإخوان لذلك كان يدخن السجائر ولما تم حل الجمعية تم القبض على جميع أعضائها ومنهم الأستاذ أحمد رائف ولما خرج من السجن قرر أن يكتب ما شاهده، واعتقل في 25 أغسطس 1965.
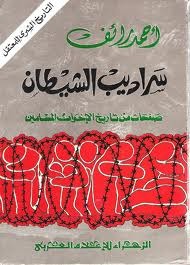
يروي فيه أحمد رائف قصته كشاهد عيان على ما كان يحدث من تعذيب في السجون خلال فترة الستينيات .
و كذلك شهادته على الاحداث السياسية خلال هذه الفترة و الصراع بين عبد الناصر و الاخوان لفرض الهيمنة و كيفية صعودهما معا .
كذلك يتكلم عن أسلوب القمع و كيفية المعيشة في المعتقل و ما كان يلاقاه المعتقلون من تعذيب وتجويع
لتحميل الكتاب
زنزانة بلا جدران .. لطفي حداد
هذا الكتاب هو ثمرة علاقات طيبة وجميلة مع بعض الأدباء الذين تعرضوا للسجن، لكن الزنزانة، رغم برودتها وظلامها ووحشتها، لم تستطع أن تحبس شوقهم إلى الحياة، أو توقهم إلى النور، أو رغبتهم في الحب، وإصرارهم على الفرح ورؤيا الخلاص. وهكذا صارت قصائد “فرج بيرقدار” التي هربها من السجن على لفائف السجائر “حمامة مطلقة الجناحين”، وتحولت كلمات “علي الدميني” إلى “نعم في الزنزانة لحن”، وتغير مدار السجن عند “منصور راجح” إلى “مدار الحب”. إن ما يجمع هؤلاء الشعراء الثلاثة هو السجن، والكتابة فيه وعنه، كم مؤلم أن تضيع سنوات من عمرهم داخل زنزانة ربطة خانقة معزولة، لأنهم قالوا آراءهم، فصاروا سجناء رأي. لم يدعوا إلى العنف، لكن العنف لم يرحم إنسانيتهم وإيمانهم بالحق والحرية. قرأت أعمال هؤلاء الشعراء وشعرت أنني مطالب بأن أوصل رسالتهم إلى الجميع، فوضعت مقدمة عن كل منهم، مع نماذج شعرية ونثرية. أفردت للشعراء: منصور راجح، علي الدميني، وفرج بيرقدار، قسماً كبيراً من الكتاب كي يقرأ ضمير ما فعله بأبنائه، وكي يكون نتائجهم الأدبي شهادة على الظلم وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد العربية، ساعياً لتعرية الجرح النازف كي لا يعود الزمن الأسود إلينا. ازداد اهتمامي بهذا الموضوع مع الزمن فرحت أقرأ عن الأدباء العرب الذين تعرضوا للاضطهاد عبر التاريخ. اكتشفت الكثير من الشعراء والروائيين الذين سجنوا وعذبوا وقتلوا وصلبوا مسجلين خبراتهم وكلماتهم في أدب رفيع مجيد صادق يستحق أن نقرأه بإعجاب وتقدير كبيرين. بدأت من الجاهلية حتى اليوم فقرأت في العصور القديمة عن سجن الحطيئة، على بن الجهم، أبي فراس الحمداني، المعتمد بن عباد، ابن زيدون. كذلك سجن الحلاج ومقتله. أما في العصر الحديث فقد أدرجت نفي البارودي، وأدب المقاومة الفلسطينية ممثلاً بغسان كنفاني، توفيق زياد، سميح القاسم، ومحمود درويش، كذلك وضعت بعض النماذج الأدبية لبدر السياب، محمد الماغوط، عبد اللطيف اللعبي، مظفر النواب، ونوال السعداوي، بعدها ذكرت نبذات عن أدباء آخرين تعرضوا للأذى والسجن. كذلك توسع المشروع حين تعرفت على الروائي العراقي المقيم في شيكاغو “محمود سعيد”، فطلبت منه أن يكتب عما عاش شخصياً ليختصر بذلك ألم الأدباء العراقيين -رغم أن أي اختصار لذلك الألم الصارخ مجحف بحقهم- فقدم لي قصة عن مخطوطة روايته “أنا الذي رأى”، وكنت قد قرأتها بالعربية والإنكليزية، فأضاءت تلك القصة -التي عانى بشكل مشابه بها كل الكتاب الصادقين في البلاد العربية- معنى أن تكتب عن السجن والحرية في الوطن/السجن،

أيام من حياتي مذكرات زينب الغزالي
(1917 – 2005)
داعية وسياسية مصرية تنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين
تأليف : زينب الغزالي
كتاب أيام من حياتي ، لزينب الغزالي ، هو جوهرة من جواهر أدب السجون ، كتب هذا الكتاب بحرف من المعاناة والآلام جراء ما لاقته زينب الغزالي في سجون الرئيس جمال عبدالناصر وما لاقاه الإخوان المسلمون في خمسينات وستينات القرض الماضي من تشريد واعتقالات وتعذيب .
تحكي لنا زينب الغزالي في هذا الكتاب سيرتها الذاتية في تلك الفترة وتجربتها مع الإخوان المسلمين وصلاتها ببعض القادة البارزين في الجماعة وبشباب الإخوان المسلمين ، وتستعرض لنا سعيهم وأفكارهم خلال هذه الفترة من القرن الماضي ، والطرق التي وضعوها لتحقيق هذه المساعي ، وما حلّ بهم جراء السعي وراء هدفهم ، وافردت الكاتبة المساحة الأكبر من فصول هذا الكتاب لتبين لنا حجم المعاناة والألم والتعذيب الذي لاقته في السجون وغيرها من شباب الإخوان ، فقد تعرضوا لكل أنواع السباب والإهانات والضرب والتجويع والاعتقال الفردي والتجريد من الملابس في بعض الأحيان ، والتعذيب بشتى الطرق ، ولتبين حجم الكراهية التي كان يحملها جمال عبدالناصر تجاهها وتجاه جماعة الإخوان ، ومحاولات الاستمالة لها ولغيرها، مقابل الإفراج عنهم .
المؤلف كتاب أيام من حياتي والمؤلف لـ 2 كتب أخرى.
زينب محمد الغزالي الجبيلي (1917 – 2005) داعية وسياسية مصرية تنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين ، وكانت إحدى الأعضاء البارزات في الاتحاد النسائي مع هدى شعراوي .
نسبها ونشأتها
ولدت زينب محمد الغزالي الجبيلي في 2 يناير 1919 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية ، وكان والدها من علماء الأزهر، وكان جدها تاجرا شهيرا للقطن ووالدها من علماء الأزهر الشريف وكان يعمل أيضًا تاجرًا للقطن، ووالدتها من عائلة كبيرة في قرية (ميت يعيش) مركز (ميت غمر) محافظة (الدقهلية)، ولدت السيدة زينب الغزالي في الثاني من يناير سنة 1919م الموافق الثامن من ربيع أول سنة 1335 هـ، توفي والدها في سن مبكرة سنة 1928م، وكان عمرها آنذاك حوالي أحد عشر عامًا.
دراستها
درست زينب الغزالي في المدارس الحكومية وتلقت علوم الدين على يد مشايخ من الأزهر، فبعد وفاة والدها انتقلت مع والدتها إلى القاهرة للعيش مع إخوتها الذين يدرسون ويعملون هناك ولم يوافق أخوها الأكبر محمد على تعليمها رغم إلحاح زينب وإصرارها .
واقتنى لها الكتب. وأهمها كتاب لعائشة التيمورية عن المرأة. حفظت زينب أكثر مقاطعه. لكنها لم تكتف بالكتب والقراءة الحرة .
ثم انتقلت بعده إلى الصف الأول وبعد شهرين من انتظامها في الدراسة أجرى لها اختبارا ألحقها على إثره بالفصل التالي. وهكذا درست زينب في المدارس الحكومية لكنها لم تكتف بذلك. فأخذت تتلقى علوم الدين على يد مشايخ من الأزهر منهم عبد المجيد اللبان ومحمد سليمان النجار رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر .
والشيخ علي محفوظ من هيئة كبار العلماء بالأزهر .
وبهذا جمعت زينب بين العلوم المدرسية الحديثة والتقليدية القائمة على الأخذ المباشر من الشيوخ .

اسمي جوقة لأننا كثيرون
قراءة في رواية “المسكوبية: فصول من سيرة العذاب” لأسامة العيسة
موسى م. خوري
حمل أسامة العيسة في روايته “المسكوبية: فصول من سيرة العذاب”، الصادرة عن مركز أوغاريت 2010، همّ كنس أزقة مدينة القدس بفرشاة أسنان، ونجح في أن يحرر روايته من متلازمتين أدبيتين فلسطينيتين: البطل الشاطري، والسجن/ النفق. أقف، قبل مقاربة هذه الأطروحة الثلاثية، على ثلاث عتبات من عتبات الكتاب لها دلالات ملحوظة مخطط لها. العتبتان الأولى والثانية تلتحمان لتبسطا، بالإحالات المضمنة فيهما، جامِعَ النص، والعتبة الثالثة عتبة مشاكسة تمتلك كمونَ حيرة، ويمكن أن تخلّق دهشة من عيار ثقيل، تحسب لشكل الكتاب ومضمونه معا.
الصورة على عتبة الغلاف الأمامي، والممتدة لتتداخل مع صورة/صور عتبة الغلاف الخلفي، تنبئ بالتحول الذي طرأ على المكان المعيّن في عتبة العنوان الرئيسي “المسكوبية”، الذي صار ثيمة ضابطة لتفريعات الاعتقال والتعذيب والإكراه، وصولا إلى السجن الكبير الذي هو الاحتلال الإسرائيلي. والرواية، من صفحتها الأولى التي تغطيها صفحة الغلاف الأمامية إلى صفحتها الأخيرة التي تغطيها صفحةُ الغلاف الخلفية، تظل سياحة في تغير المشهد/ المسكوبية، باعتباره المكان الصغير المتناهي في الكبر (مع كل دلالات الصغر والكبر)، وباعتباره أيقونة – بلغة مايكروسوفتية – تنفتح على المكان الأرحب الذي أحال العيسة في روايته على مداميكه الأصغر التي تتلاحم لتحقيق كبره – مدينة القدس.
كان لعتبة الخطبة أثر ليس بسيطا عليّ، فقد خربطت في البدء مياهي الجوفية بالمعنى السلبي للخربطة، ثم خربطت – لاحقا- مياهي الجوفية بالمعنى الإيجابي. ما فاق حد الإزعاج عند قراءتي لعتبة الخطبة أنها قدمت مسردا لسجناء النخبة في فلسطين، وصرت أحسب – مدفوعا بلا براءتي التي يسوغها غياب براءة فعل الكتابة أصلا – أن الكاتب مهووس بالانتماء إلى طبقة خطط منذ جيل مبكر، وهو الفتى القابع في سجن المسكوبية، أن ينتمي إليها – طبقة الكتاب. صارت القدس في الخطبة قدسَ النخبة التي تقدمها كتب مقرر اللغة العربية وكتب التاريخ، وبدأت أحسب أن هذه العتبة/البوابة ستؤدي إلى خرابة. لأني طويل أناة عندما يصير الأمر متعلقا بالقراءة، ولأني أحاول أن أكون القارئ الذي اشتهيه عندما أكتب أنا نصا، تابعت القراءة واكتشفت أنني أمام كاتب مهووس بالخلخلة وينتمي إلى الرصيفيين، ويزاحمني على ذلك وأحب مزاحمته. صارت الخطبة بعد قراءة الرواية (وأي قراءة واعية هي قراءة مقارنة بالضرورة) هي النص الذي أراد الكاتب في جوانب كثيرة من روايته، التي تنتمي إلى أدب السجون، أن يخرقه وبتدبير مسبق. ما أتى في الرواية، بعد مسرد النخبة في الخطبة، توثيق لحياة المهمشين والرصيفيين الذين، وإن ظلوا في ذاكراتنا، يظلون أرقاما أو أسماء تراكم سجلنا الوطني في خانة السجن أو النضال أو الاستشهاد، ودون احتفاء بتفاصيل اليوميات التي توثق لحقيقة أنهم كانوا، قبل أي شيء، وحتى قبل رصيفيتهم، أناسا من لحم ودم.
في قراءة له يعيد فيها اكتشاف الشاعر الفلسطيني الرصيفي طه محمد علي، استثمر الكاتب والأكاديمي والمترجم الفلسطيني أنطون شماس عبارة مجهولة السياق لشاعر يوناني (أركيلوكس) عاش في القرن السابع قبل الميلاد، والعبارة هي: “الثعلب يعرف أمورا كثيرة، أما القنفذ فيعرف أمرا واحد كبير الشأن”. يقول أنطون شماس في اتكاء على تأويل للعبارة ورد في دراسة عن تولستوي الحرب والسلام لكاتب وأكاديمي ثعلب هو إشعيا برلين : “الكتّاب – ولا فضل لأحد على أحد إلا بالموهبة – يمكن أن يصنّفوا بين عالمين: عالم القنافذ وعالم الثعالب، بين أولئك الذين يردّون الأمور إلى منظومة واحدة تهيمن على كل شيء، إلى فكرة كبرى تنظم العالم ومن خلالها يدركون الأشياء فكريا وعاطفيا، وبين أولئك الذين يطاردون أمورا شتى قد تبدو في غالب الأحيان متناقضة للناظر، لا علاقة ظاهرة بينها ولا تنضوي تحت مبدأ أخلاقي أو جمالي واحد”. أسامة العيسه، في متتالية استثمارية للعبارة اليونانية، قنفذ مغرق في قنفذيته، فهو يعرف في عمله هذا وفي أعماله الأخرى وفي كثير من تلفظاته التي ترد في نصوصه الموازية، يعرف شيئا واحدا عظيم الشأن، يعرف أنه صاحب مشروع روائي لتقديم الزمان والمكان الفلسطينيين سرديا.
ليس الذي شدّني في قنفذة الكاتب تركيزه على القدس باعتبارها المكان الذي يشغل حجر الزاوية في ذاكرتنا المكانية فقط، بل باعتبارها “المكان قيد الصيرورة”، المكان الذي نسهم جميعا، البدو والأحباش والأقباط واليونان والنور والعرب المسلمون والمسيحيون، بنسج علاماته الفارقة، لكن كل بخيطه ومسلته. في نص غير بصير يرد في مقرر اللغة العربية الفلسطيني للصف السادس تصير الإحالة على كنيسة القيامة، مثلا، باعتبارها الـ (مكان) الذي يحوي تمثالا مرصعا بالجواهر للسيدة العذراء، وفيه مصابيح ثمينة. تظل الكنيسة، بما تحويه، مشلّحة من اسمها (القيامة) الذي يحيل، بكل دلالاته الميثولوجية، والوطنية، والأدبية الاستعارية، على الذي يحيل عليه. صك دولوز وجواتري، في دراستهما لأدب كافكا، التشيكي اليهودي الذي كتب بالألمانية، مصطلحَ “الماينور ليتيرتشر”، أو الأدب الذي تنتجه الأقلية بلغة الأكثرية والذي يمتاز بطابع تفكيكي لصيغ الأكثرية ومروياتها الشرعية والمشرعنة التي ترعاها الـ “سلطة؛ وكتب أسامة العيسة نصا ينتمي إلى هذا التصنيف لأنه نأى بالقدس عن مقرر اللغة العربية الذي يجعل المدينة مدينة يتعهد “مؤرخوها الجدد” للـ “أقليات” بذكر مجزوءِ مقدساتهم ومروياتهم التي أسهمت قطعا في تشكيل راقات وتراكمات ثقافة المكان.
مشى العيسة أميالا إضافية في نص المسكوبية، وذكر الذين ذكرهم وقدم – بدفع من وعيه القائم بتنميط المكان – وعيا ممكنا أساسه رؤية لعالم المدينة باعتبارها نصا يقتات على نصوص كثيرة. قدس العيسة، التي يكنسها بفرشاة أسنان، تظل في الرواية لوحة فسيفساء شكّلها تراص مداميك حجارتها الصغيرة المتناهية في الكبر، حجارتها المختلفة بانسجام والمنسجمة باختلاف. تذكرني قدسه بمروية القديس مرقس حين أحال على حادثة السيد المسيح الذي قبل أن يطرد الأرواح الشريرة من ساكن المقبرة سأله: ما اسمك؟ فأجاب: اسمي جوقة لأننا كثيرون. القدس في الرواية جوقة لأنها كثيرون، وفيها تبرز التفاصيل الصغيرة التي حذرنا درويش من إسقاطها في سطره البصير: “سنصير شعبا حين ننسى ما تقول لنا القبيلة، حين يعلي الفرد من شأن التفاصيل الصغيرة”.
من العلامات الفارقة الأخرى لهذه الرواية تبطيل البطل. أبطال الرواية يعرفون ولا يعرفون، أو لا يوسمون دائما بفضيلة المعرفة. ظلت فضيلة اللامعرفة سمة في مواقف كثيرة لهم، ما جعل الرواية رواية مشغولة بالسؤال أكثر من انشغالها بالجواب. في السياق ذاته، تخلت الرواية عن الشاطرية بالمفهوم الشعبي، فالبطل فيها ليس شاطرا حسنا يوهب البطولةَ ولا يصنعها، وشخوص الرواية من المساجين ليسوا فوق الحزن والألم، وأمهم – إن ماتوا – تنهدّ، فـ”الأم أم حين تثكل طفلها تذوي وتيبس كالعصا”.
احتفت الرواية، وهي تبطل البطل، بالحميم واليومي والرصيفي كذلك، فيها نرى العالم السفلي، وفيها – وهنا الأهم – نعيش تجربة السجن في اليومي، ولا نعيشها في عتمة النفق الذي سيفضي، وإن بعد كثير من التأبيدات، إلى النور. لم نعش في الرواية حالة الوطان التي يعيشها كثير من العرب في مهاجرهم حين يعلقون اليومي ويعلقون معه دوران أضراس الحياة والعمر لأنهم سيعودون يوما ليشربوا حليب البلاد. اعتنت الرواية بالنفق لأن التجربة التي تصير فيه لا تقل أهمية عن النور الذي في آخره؛ فهو ساعة يضج بالحياة يصير منيرا بفعل أنسنة المقيمين (السجناء والسجانين) الذين لا تصير حياتهم فيه مع وقف التنفيذ انتظارا لخلاص مفترض.
أغلب المقالات التي تناولت هذه الرواية في صحافتنا المحلية أو العربية عابت عليها محدودية حركة الحدث الدرامي، أو وسمتها بالتشظي الذي أحدثته كثافة الالتجاء إلى صيغة التحقيق الصحافي، لكن أحدا من كتاب هذه المقالات لم يشر إلى أننا يمكن أن ننظر إلى شكل الرواية، في بندوليته المراوحة بين الحيرة والمعرفة والاستباق والاسترجاع والتقريرية الصحافية والتنظير، باعتباره شكلا مماثلا لحالة اللاثبات في الواقع الفلسطيني، ليصير شكل الرواية، والحال، مضمونا. يمكن لقارئ مخلص أن يضع الرواية في زنازين كثيرة، بل يمكن أن يشبحها، بلغة السجن، ويضع على رأسها كيس خيش معشقا برائحة ما، ويمكن أن يثير أسئلة كثيرة حول مبرر بروز “حصون تارجت” في خطبة الكتاب (السجون التي بناها البريطانيون) على حساب المسكوبية – مكانا وعنوان نص، ويمكن أن يشار إلى مواقع كثيرة يحتاج فيها النص لتحرير أسلوبي ولغوي من عيار معقول. يبقى، مع كل ذلك، أن هذه الرواية التي استحقت الجائزة العربية للإبداع الثقافي عن فئة الرواية (2013) حققت، مع غيرها من الأعمال بالضرورة، خرقا ثلاثيا: انتصرت للتفاصيل الصغيرة المتناهية في الكبر، ونزعت سمة الشاطرية عن بطل السجون وانحازت لأنسنته بطلا يصنع البطولة ولا تهبها له بنائية فلاديميرية (نسبة إلى وظائف فلاديمير بروب الدراماتيكية في كتابه مورفولجيا الحكاية الخرافية)، وأنارت النفق (الزنازين وغرف التحقيق وغرف الحبس) الذي يضج بحياة آدميين يتحدون حياةً أرادها سدنة المسكوبية، وغيرهم، حياةً مع وقف التنفيذ.
أكاديمي وكاتب فلسطيني.
نوفمبر 12, 2021 Uncategorized 0
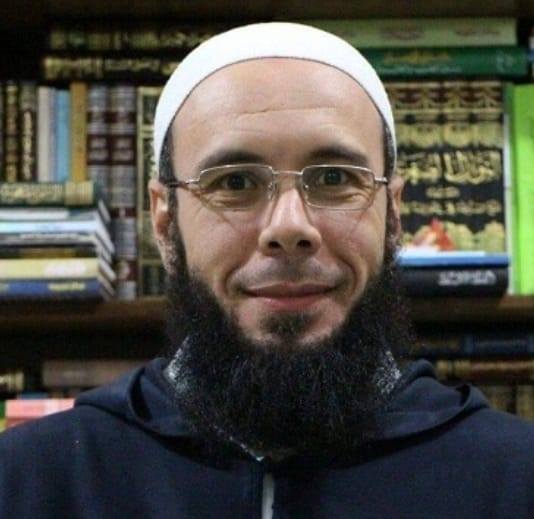
أكتوبر 31, 2021 ذاكرة ضد النسيان 0

عبد الله الحمزاوي
معتقل اسلامي سابق

 أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد
أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد