جاسم وشيخو وأبو حميد
هذا العنوان ليس اسماً لمسلسل إذاعي أو تلفزيوني، بل هو عنوان لمسلسل التعذيب في فرع مخابرات حلب في الحقبة التي كنت فيها ضيفاً على ذلك الفرع.
جاسم هو زعيمهم. لا أعرف اسمه بالكامل. يقال إنه جاسم الطِّيط، ويقال: جاسم سلطان. ولكنه يُعرف عادة باسمه: جاسم، أو بكنيته: أبي الفوز.
لقد حَرَمَهُ الله من أي جمال في خلقته، لكنه كان صاحب ذكاء خاص في اقتناص الفرص، كما سأوضِّح.
وكان يتباهى في أنَّه تخرّج على يديه الوزير الفلاني، أو المسؤول الكبير الفلاني، بمعنى أنهم اعتُقلوا عنده قبل تولِّيهم وظائفهم، أو بعد إخراجهم منها، ونالوا من يديه القويَّتين سيلاً من الخيزرانات، وغير ذلك مما يجود به حذاؤه، ولسانه كذلك!.
ويبدو أنه أطول الجلادين مدةً في هذه المهنة الشريفة، وهو يحسّ بالحرج، بل بالخوف الحقيقي وهو يسير في الشارع، أو يدخل بيته، أو ينام فيه!، أو يتسوَّق لعياله… بل يخاف على أولاده كذلك… فأعداؤه كُثُر، وكل من تلقّى منه تعذيباً فهو عدوٌّ له، ولا يأمن جاسم أن ينتقم منه بعض الأعداء!.
ولهذا فقد اتخذ لنفسه “استراتيجية أخرى” وهي أن يمتنع عن اصطناع أعداء جدد بقدر المستطاع، فإذا لم يكن مضطراً فإنه يتهرب من ممارسة التعذيب المباشر، بل يدفع إلى هذه المهمة بعض شركائه مثل شيخو وأبي حميد ومحمد وردة (الحمصي)… وفوق ذلك فإن استراتيجيَّته تقتضي أن يمارس النهب بأسلوب آخر. فهو يعيش في حلب منذ سنوات طويلة ويعرف كثيراً من تجارها ووجهائها… فكلما جاءه أحد المعتقلين سأله ما اسمك وما اسم أبيك، وما اسم أمك؟…
ثم يسأله: ما القرابة بينك وبين فلان، وفلان، وفلانة؟!. فإذا عرف أنَّ فلاناً عمه أو خاله أو ابن أخته أو… قام بجولة عليهم في أماكن عملهم أو بيوتهم الخاصة ليأخذ منهم الرشاوي بمقابل أن يحسن التعامل مع قريبهم المعتقل!. وقد تكون الرشوة نقوداً أو تكون ساعة يد، أو قطعة أثاث، أو بعض الألبسة… حسب اختصاص كل من هؤلاء الأقرباء.
أما “شيخو” فهو كما يقول عن نفسه: “شيخو أبو الشوارب”، أسمر البشرة، طويل القامة، له شاربان كبيران جداً، أسودان لامعان، يجعلان شكله مخيفاً.
وهو كردي، من قرية كفر جنّة، متعصب لقوميته، في لهجته العربية أثر واضح لكرديته، فهو يخلط مثلاً بين المذكر والمؤنث. وعلى الرغم من حبه الشديد للتعذيب، يراعي المعتقلين الأكراد قدر استطاعته!.
في أحد الأيام كان شيخو مناوباً، ينام في الفرع، وعند شروق الشمس سمع خبطاً على باب إحدى الغرف، واستمر الخبط حتى قام شيخو من نومه غاضباً وأتى بالخيزرانة معه ليؤدِّب هذا الذي يتجرَّأ على إيقاظه في هذه الساعة المبكرة، وقبل وصوله راح يصرخ: من هذا الذي يدق الباب؟ فجاءه الجواب: “آس. آس” وهي بالكردية تعني: “أنا. أنا” إذاً فالمعتقل هو أخونا طالب كلية الطب مستو، فابتلع شيخو غضبه، وظهرت البسمة على وجهه، وفتح الباب للأخ مستو حتى يقضي حاجته.

وأكثر من مرة كان يؤتى ببعض المعتقلين الأكراد، وقد يؤمر شيخو نفسه بتعذيبهم، فيقوم بذلك، إذا كان المحقق فوق رأسه، لكنه في غياب المحقق كان يحاول أن يكرمهم.
ومن المآسي الصغيرة! أن عدد الملاعق التي خصصت لنا، كانت أقل من عددنا، وبعض الطعام كالمرق، يصعب تناوله من دون الملاعق. وكان أحد إخواننا في وضع صحي خاص، فكنّا نكرمه بأن نخصّص له ملعقة!. ولما شعر شيخو بذلك، خاطبَ أخانا مستو، باللغة الكردية: لم تعطون هذا العربي ملعقة؟! وظهر الغضب المكبوت في وجه مستو، ولما ذهب شيخو قام مستو بترجمة ما سمعه!.
وشيخو هذا أمِّيّ، لكنه يضع في جيب السترة على صدره، ثلاثة أقلام أو أكثر! وإذا رفع سماعة الهاتف، وسأله الطرف الآخر: مَنْ؟ أجاب: شيخو أبو الشوارب.
وقد قرّرت إدارة الفرع إجراء دورة محو أميّة لعناصر الفرع، ومنهم شيخو هذا، فكان يحضر الدروس لكنه لا يفهم شيئاً، وإذا أعطاه المدرّس وظيفةً ليكتبها، طلب من أحد المعتقلين أن يكتبها عنه! فإذا قدّم الوظيفة للمدرّس تبيّن له أنها ليست بخط شيخو، فيطلب من إدارة الفرع معاقبته! ثم يأخذ وظيفة أخرى، ويحاول أن يكتب، وكلما كتب حرفاً أو رقماً بدأ يشتم: “يلعن أبوه هذا أربعة” أي يلعن الله الرقم 4. ما أصعب كتابته! (ونكتفي بهذا المثال عن أمثلة أخرى فاحشة).
وكان أحد إخواننا المعتقلين ينصح شيخو أحياناً فيقول له: يجب أن تترك الخمر، فالخمر وبال عليك في الآخرة، وهدم لصحتك!. فيقول: لا. أنا مرضت وذهبت إلى الطبيب فكتب لي في الوصفة: “واحد فروج، وواحد عرق”! قلت له عندئذ: وهل صرفتَ الوصفة من الصيدلية أم من الخمارة؟!. فنظر في وجهي ولم يُحِرْ جواباً!.
ويقصّ علينا هذه القصة التي تصور شخصيته، فيقول:
مرة طلب مني النقيب أن أعذِّب أحد الموقوفين، وصعد النقيب إلى غرفته في الطابق الأعلى، فوضعتُ القيد في يَدَي الموقوف (المعتقل) حتى تقلَّ حركته، وأتمكن من ضربه كما أريد. ورحت أضربه بالخيزرانة مرة، وبعصا غليظة مرةً، وبعقب الحذاء مرة ثالثة.. ولم أشعر إلا وقد انكسرت يده كسراً ظاهراً، وهو يصرخ من شدة الألم. خفت أن يعاقبني النقيب على ذلك. فاتصلت به هاتفياً: سيدي، هذا الذي قلتَ لي: عذِّبْه، لقد انكسرت يده.
(وأراد المحقق أن يطمئنه فقال له): “يلعن أبوه. خلّي تنكسر إيدُه التانية” : فلتنكسر يده الثانية.
فقال شيخو: حاضر سيدي.
وراح يضرب الضحية بقسوة بالغة حتى كسر يده الثانية. استجابة لما فهمه من كلام النقيب!.
قلت لشيخو: وكيف تفعل ذلك؟! قال: النقيب ربّي! فإذا قال لي: اكسر يده فأنا أكسرها!.
ونكتفي بهذا الحديث عن شيخو لننتقل إلى الجلاد الثالث:
أبو حميد: هو الآخر كردي، لكنه يتكلم العربية بلهجة حلبية تامة، مع احتفاظه بلغته الكردية.
وهو ضخم الجسم، جميل الهيئة، قوي البنية جداً. كان يعمل -قبل دخوله هذه الوظيفة- عتّالاً ينقل الحمولات التي يعجز عنها العتّالون الآخرون!.
وإذا أُمر بالتعذيب قام “بواجبه” على أكمل وجه، لكنه إذا غاب عن أعين المحقق بدا لطيفاً مهذباً.
كان هو الآخر أميّاً، فكنّا نكتب بعض الرسائل إلى أهلينا وأصدقائنا، ونرسلها مع أبي حميد، بمقابل خمس ليرات للرسالة الواحدة، ونشرح له العنوان فيوصلها بأمانة، وقد يأتينا برسالة جوابية بمقابل أجر آخر، يأخذه منهم.
وأحياناً يحمل رسالتين أو ثلاثاً في آنٍ واحد. وبما أنه أمّي، كنا نخاف أن يخطئ فيسلِّم الرسالة إلى غير صاحبها، فننبهه إلى ذلك فيقول: لا تخافوا. رسالة فلان هنا في هذا الجيب، ورسالة فلان في جيب القميص، والرسالة الثالثة في الجيب الخلفي. وبالفعل كان يصيب الهدف!.
ومرة اعتُقل مجموعة من عصابة تضم أطباء فمَنْ دونهم، من مستشفى حلب العسكري. وكانت هذه العصابة تأخذ الرشاوي من المواطن حتى تهيّئ له سبيل الإعفاء من الخدمة العسكرية…
في أثناء التحقيق مع أحدهم يقول المحقق حيزة: ألا تخجلون على أنفسكم تأخذون الأموال من أجل تمكين المواطن من التهرب من خدمة العلم؟!.
فيتدخل أبو حميد فيقول: سيدي. هل تظن أن كل الناس مثلي ومثلك، يعيشون على رواتبهم؟!.
وقد ذكرتُ آنفاً كيف كنا ندفع الرشاوي لأبي حميد. أما الحيزة فقد كانت رشاواه بأسعار باهظة.
فقد جيء مرة بمهرِّب حشيش على مستوى دولي (يهرِّب بين الدول)، وضبطت معه بضعة عشر كيلوغراماً من هذه المادّة. فلما وصل إلى الفرع ووضع تحت التعذيب، أشار بطرف عينه إلى المحقق، والتقط المحقق الإشارة، فصَرف الجلاد من الغرفة.
ثم كتب التحقيق بالشكل الذي يرضي المهرِّب. ثم طَلَبَ له فطوراً -على حساب المهرِّب- وهو “مامونية”، من عند المستّت!.
ووضعه المحقق في غرفتنا بضع ساعات إلى أن أُفرج عنه. وقد حدَّثنا أنه دفع للمحقق ثلاثة آلاف ليرة مقابل ذلك!.
رئيس فرع الحلبوني
عندما نُقِلنا من معتقل فرع المخابرات في حلب إلى فرع الحلبوني في دمشق، في مطالع أيلول 1973م، كان رئيس الفرع هو الرائد عارف نصر، وهو شخصية غامضة، يُدير الأمور من وراء جدار!. فقد بقينا “ضيوفاً” عليه مدة تزيد على أربعة عشر شهراً، ولم نجتمع به مطلقاً. نعم قد نراه خِلْسة، ونحن نتسلّق أعالي النوافذ، فربما صادف ذلك دخولَه إلى مبنى الفرع عبر الساحة الواسعة، فكان دخوله يقترن “بخشوع” ظاهر من السجانين والحرس.. إذ إن مِشْيته تدل على تجبّر وغطرسة.
كان يدير الفرع بشكل مباشر اثنان:
المحقق آصف يتولى أمور التحقيق والتعذيب ويُعدُّ ملفّات الموقوفين، ويرفع التوصيات بشأن التوقيف (الاعتقال) والإفراج.. وهو ضابط في مطلع الثلاثينيات من عمره، محدود الثقافة والذكاء!.
والمساعد شلحة (لا أعرف اسمه الأول)، يتابع الأمور الإدارية، من دوام للعناصر، وترتيب الحراسة، وتنظيم خدمات الطعام وغير ذلك. وهو كذلك ضعيف الثقافة والذكاء، قاسٍ جَلف. قد يتولى التحقيق في بعض المسائل الصغيرة.
وهو يعترف –بلسان حاله- أن الإخوان هم الأكثر نظافة في أخلاقهم وسلوكهم.. وفي طعامهم وثيابهم ومكان إقامتهم كذلك. فإذا جاءت توصية بأحد المعتقلين الجدد، فإن المساعد شلحة يضع هذا المعتقل الجديد في غرفة الإخوان، تكريماً له، وحفاظاً على نظافته البدنية والخلقية.
ولسنا ندري شيئاً عن العلاقة بين رئيس الفرع وبين كل من “آصف” و”شلحة” هل هي علاقة مودّة، أم علاقة إدارية وظيفية فحسب.
——————–
في أواخر العام 1974م حدث تغيير في إدارة الفرع، فقد عيّن رئيس جديد له، إنه الرائد محمد أحمد فتح الله.
كان متوسط الطول، أبيض البشرة، هادئاً ورزيناً.
وهو من منطقة يبرود -بين دمشق وحمص- وقد كان قبل ذلك “بمنصب القاضي الفرد العسكري”.
وكان مجيئه محاطاً لدينا بالغموض، فهل سيكون كسَلَفِه أم أقلّ سوءاً، أم أشد؟!.
واستمرّ الأمر نحو أسبوعين حتى بدأنا نلحظ ثمرات التغيير:
1- أجرى رقابة على طعام الموقوفين، فعلم أن السجانين يسرقون أفضل الطعام، ويوزعون الباقي!. وأَمَر بسجن الرقيب أول أحمد سيفو (وهو ابن أخٍ للوزير شتيوي سيفو) بسبب سرقته بعض الطعام.
2- أمر بإعطاء الموقوفين حق الخروج إلى الباحة للتنفس، مدة نصف ساعة يومياً. (كنّا قبل عهده نخرج مرة واحدة في الأسبوع، لمدة عشر دقائق!).
3- اطّلع على ملفّات الموقوفين فوجد أنهم مظلومون، وليس هناك مسوّغ لاعتقالهم، فبدأ يرفع الكتب إلى إدارة المخابرات العامة يوصي بالإفراج عنهم. فاستجابت الإدارة فأفرجت عن بعض أصحاب القضايا الفردية البسيطة.
4- عندما لم تستجب الإدارة بالإفراج عن معظم المعتقلين، رفع كتاباً يقول فيه: إذا لم تستجيبوا، فلا أقلّ من أن تنقلوهم إلى سجون مدنيّة، حيث يمكن أن ينالوا بعض حقوق السجناء!. فاستجابوا لطلبه هذا، وتم نقلنا فعلاً. وكان نصيبي من سجن حلب المركزي، وخفّت بذلك وطأة السجن، فأين سجون المخابرات من السجون المدنية؟!.
لكن إدارة المخابرات العامة وجدت أنَّ هذا الرجل لا يصلح أن يكون رئيساً لفرع مخابرات، فمثل هذا المنصب يحتاج إلى ظالمٍ فظّ غليظ القلب حاقد لئيم.. فلم تمض سنة على توليه منصبه هذا حتى تم نقله إلى مكان آخر!.
الجلاد أبو طلال
إنه من أشهر جلادي فرع الحلبوني. لكن الاقتصار على وصفه جلاداً، لا يوضح حقيقة شخصيته، بل إن فيه بعض الظلم له.
بلغ من شهرته أنَّ بعض عناصر المخابرات في فروع أخرى، غير الحلبوني، يكنيّ أحدهم نفسه بأبي طلال تيمّناً بأبي طلال الحلبوني، ويطيل شاربيه ليكونا مثل شاربي أبي طلال.
والقلائل هم الذين يعرفون اسمه الحقيقي، فيكتفون بكنيته: أبي طلال.
اسمه هشام الشيخ نجيب، ويقال: إنَّ أباه شيخٌ بالفعل، لعله إمام مسجد مثلاً. وهو دمشقي.
وشخصيته غنية بالصفات المتناقضة، أو لنقل: بالخطوط ذات الألوان المختلفة.
تلمس فيه بعض الذكاء، وبعض العنف، والقدرة الكبيرة على التعذيب مع الروح الساديّة، وبعض التديّن، وبعض الوطنية، وكراهية حزب البعث الحاكم، وفيه قوة في الشخصية، وتعدد في المواهب، وفيه بعض الطِّيب، وبعض الجهل.
وحين نذكر بعض مواقفه تظهر تلك الخطوط المتباينة.
أحياناً يطلب المحقق من أبي طلال أن يقوم هو بدور المحقق في بعض القضايا الصغيرة، وعندئذ يبدو ذكاؤه، إذ يستطيع استخلاص الحقائق من دون أن يضرب المتهم صفعةً واحدة أو سوطاً واحداً. قد يهدد، وقد يمسك بيده الخيزرانة ويلوح بها ويضرب بها الأرض أو الحائط.. ويرفق ذلك باستدراج الموقوف (المتهم) حتى يستخرج منه الاعتراف المطلوب.
وإذا أصيب أبو طلال بمرض أو أصيب أحد أفراد أسرته فإنه يقول: لا شك أنَّ ذلك نتيجة دعاء أحد المظلومين الذين تولّيت تعذيبهم.
وإذا اقتضت منه مهنته أن يعذب أحد المتدينين، ولم يكن المحقق فوق رأسه، فإنه يختار أحد المسجونين غير المتدينين فينسب إليه ذنباً ما، ويفرغ فيه شحنة الغضب، حتى إذا وجد أنَّ الغضب ذهب عنه أمسك بالمتدين ليضربه ضرباً خفيفاً، أو يكتفي بتوبيخه…
وإذا جيء بموقوف من جنسيات غير سورية، وبخاصة إذا كان أوروبياً أو أمريكياً فإنه يتفنَّن في تعذيبه بمبادرة منه! وإذا سئل عن ذلك قال: إن أبناء وطننا يلقَون سوء العذاب عندنا، فهؤلاء أَولى!.
ومرة يخطر في باله أن يصلّي لله تعالى، فيقف في باحة السجن ويصلي علناً، لا يخاف أن يراه أحد!.
ومرة يعلن إفطاره في رمضان، فيضع -في باحة السجن كذلك- كرسيين متقابلين، يجلس على أحدهما، ويضع الطعام على الآخر ويأكل!.
وهو صاحب “مَقْمَرة” أي مقهى للعب القمار، يعمل فيها خارج أوقات الدوام، ويشغّل فيها بعض الشباب الأشقياء، ويستغلّ وظيفته في حماية المقمرة والعاملين عليها.
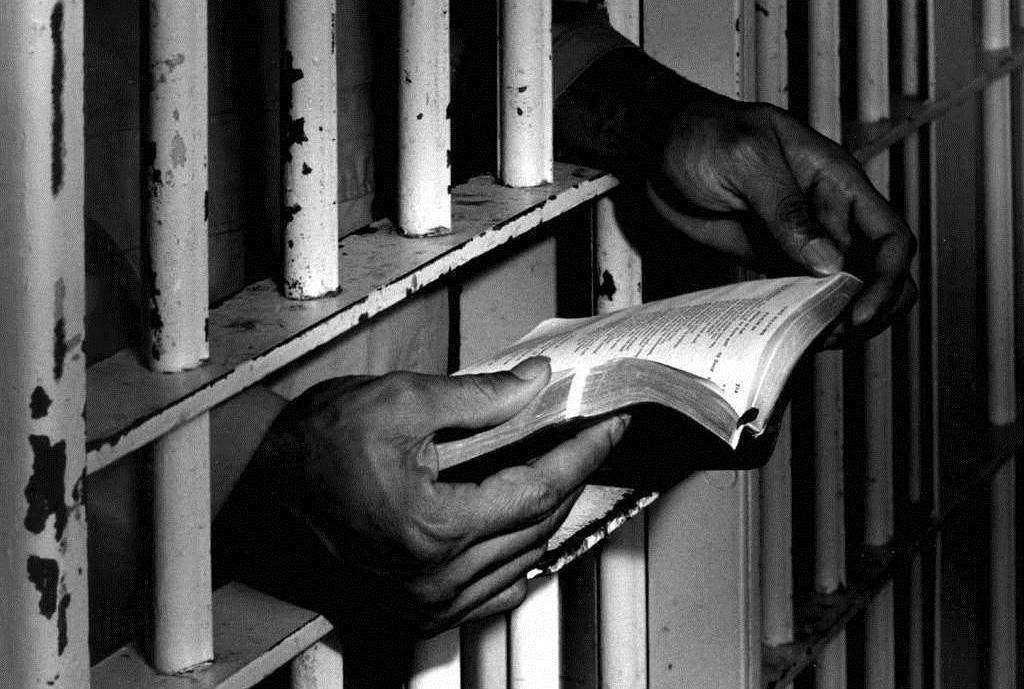
ومرة كان في أحد النوادي الليلية (الكباريهات) واشتبك مع عناصر من سرايا الدفاع، لا أعرف سبب الاشتباك، لكن عناصر المخابرات (من روّاد الكباريه) وقفوا مع أبي طلال، ضد عناصر السرايا (من روّاد ذلك المكان) وتبادلوا إطلاق النار على الخفيف فأصيب بساقه، ونقل إلى المستشفى، وبعد الشفاء بقي يعرُج عرجاً خفيفاً، ولعل هذا العرج استمرّ معه وشكّل عاهة دائمة.
وكان يمتاز بضربات معينة يعذّب بها الموقوفين. وذلك بأن يمسك الموقوف من مقدمة شعر رأسه، ويحرّكه يمنة ويسرة، فيستجيب ولا يستطيع المقاومة، ثم يشده بقوة نحوه فيرتمي إلى الأمام قليلاً، فيضربه ضربةً قوية بساعده (قرب المرفق) فيرميه أرضاً بقوةٍ قرب الجدار، وعندئذ يدوس بعقب حذائه على رأس الموقوف ويضربه عدداً من الضربات المؤلمة المهينة… ثم يخرج مزهوّاً بانتصاره!.
وهو يعبّر بطرق مختلفة عن كراهيته لحزب البعث وقيادته، وعن ضعف ولائه للسلطة التي يخدمها! فبين الحين والآخر تضبط السلطة بعض المتسللين من العراق عبر الحدود بحجة أنهم معارضون لحكم صدام حسين وطالبون للجوء السياسي في سورية، فكانت المخابرات تعتقلهم وتزجُّهم في سجن الحلبوني لتحقق معهم فتطمئن إلى وضعهم، أو تتهمهم بأنهم مدسوسون لإحداث شغب في سورية… فحين يقول أحدهم إنني قادم لطلب اللجوء السياسي كان أبو طلال يشتمه ويقول له: أعندنا تطلب اللجوء السياسي! والله نحن لا نشبع الخبز، فكيف نطعم غيرنا؟!.
ومرة اعتقل شاب عراقي يدرس في جامعة دمشق اسمه كُوسْرَتْ، يقول: إن أباه كردي وأمه عربية، وهو بعثي مرتبط بالقيادة القومية –مكتب العراق في دمشق. وحصل أن دارت شبهة حوله بأنه متعاون مع بعث العراق، فاعتقلته المخابرات، وجيء به إلى “الحلبوني” وبدأ به التعذيب، وكان الذي يعذبه أبا طلال، فيقول كوسرت: والله يا رفيق أنا بعثي، واسألوا عني القيادة القومية، فيجيبه أبو طلال: “كذا” عليك وعلى القيادة القومية.
يحدثنا كوسرت فيما بعد، وهو يروي قصة تعذيبه فيقول: ما كنت أصدّق أن تشتم القيادة القومية لحزب البعث داخل فرع المخابرات، وأن تصدر الشتيمة من أحد عناصر الفرع!.
ومن القصص الطريفة التي حدثنا بها أبو طلال قصتان:
الأولى تدل على بقايا القيم الدينية في نفسه، وهي أن شاباً اعتقلته المخابرات في الصباح الباكر من أحد الأيام، في منطلق الباصات وهو يريد السفر، وجيء به إلى الحلبوني، ووجهت إليه بعض التهم، وطُلب من أبي طلال أن يقوم بالتحقيق معه. يقول أبو طلال: حاولت معه بالحسنى، وبالتهديد، ثم بالضرب المبرّح… ولكنه لم يعترف بشيء، فوضعته في الزنزانة بانتظار جولة أخرى في اليوم التالي، وكنت يومها مناوِباً (أي عليه أن يبيت في الفرع نفسه) ومع شروق الشمس سمعت خبطاً على باب إحدى الزنازين، فاستيقظت لأستجلي الخبر، وإذا الشاب الذي أتحدّث عنه هو الذي يخبط الباب. فتحت له الباب وقلت له: ما شأنك؟! لماذا تطرق الباب في هذه الساعة المبكرة؟! قال: أريد أن تضربني، أريد أن تعذبني فإنني أستحق ذلك وأكثر!!. قلت في نفسي: هل أصيبَ الشاب بالجنون؟! قلت له: احكِ لي قصتك، فقال: أما التهم التي وجهتموها إلي فأنا منها بريء بريء. ولكنني أستحق الضرب والتعذيب لأن أمي لم تكن راضية عن سفري، وقد أرادت منعي من السفر فعصيتها وخرجت، فهذا نتيجة غضبها، وأسأل الله أن يغفر لي.
أما القصة الثانية فتدل على مدى الرعب الذي يعيشه عناصر المخابرات، إذ صار لهم في المجتمع أعداء كثر. يقول: كنت يوماً مناوباً في الفرع. وكان علي أن أبيت هناك، لكنني كما أفعل مرات كثيرة، أبقىٰ حتى منتصف الليل ثم أذهب إلى بيتي، وهو قريب من الفرع، ويتحمل عني زملائي الأعباء إلى الصباح، وهي في الغالب أعباء شكلية.
ووصلت إلى البيت ، وبعد دقيقتين سمعت قرعاً بالباب، فقلت: لا شك أن أحد الناقمين كان يترصَّدُني، والآن يريد قتلي أو إيذائي، فلقّمتُ المسدس، وهيأت نفسي لأفتح الباب وأعاجل الواقف خلفه بضربة شديدة تجعله يتدحرج على الدرج ثم أرى إن كان هناك حاجة لإطلاق النار. وفعلاً فتحت الباب سريعاً ووجهت لكْمة قوية لهذا الطارق فتدحرج وهو يقول لي: مالَكَ يا أبا طلال؟ أنا صديقك فلان!!.
لقد كان صديقي فعلاً، وكان يعلم أني مناوب في الفرع، فجاء إلى هناك ليزورني ويسهر معي، فلما قيل له: الآن ذهب إلى البيت، لحق بي، وكان ما كان!.
الشيخ الشاعر يوسف عبيد
كان من حظّي أن تعرَّفت إلى هذا الشيخ الشاعر في سجن حلب المركزي. فبعد فترة وجيزة من نقلي إلى هذا السجن، تم نقل اثنين من السجناء السياسيين، فصرنا ثلاثة في غرفة واحدة: أنا، والشيخ يوسف، وعبد العزيز ج، المحسوب على البعث العراقي.
الشيخ أبو ضياء: يوسف عبيد رجل ضرير، ضخم الجسم، خفيف الظلّ، يحفظ القرآن الكريم، ويحمل إجازة (بكالوريوس) في الشريعة، وهو شاعر مجيد، ينتمي إلى حزب التحرير. ويكاد كل شعره أن يكون شعراً ملتزماً، بل إنَّ السبب المباشر في اعتقاله كان قصيدة قالها في هجاء حافظ أسد واتهامه إياه بالخيانة.
ولا غرابة أن يكون يوسف عبيد من فحول الشعراء، فهو من قرية “عين النخيل” من أعمال منبج وما أكثر الشعراء الفحول المنبجانيين، بدءاً من البحتري، ومروراً بعمر أبي ريشة، ثم محمد منلا غزيّل وعبدالله عيسى السلامة… ولعلّ منبج قد أنجبت شعراء كُثُراً آخرين، فلست ممّن يتابع تاريخ الأدب والحركة الأدبية.
* * *
بعد حرب تشرين “التحريرية”! قام وزير خارجية الولايات المتحدة هنري كسنجر، بزيارات، وُصفت بالمكّوكيّة، بين واشنطن وتل أبيب ودمشق. وفي إحدى المرات طال الفاصل بين زيارةٍ له وأخرى، فقد أمضى مدة تزيد على الشهر في الولايات المتحدة، تزوّج حينَها من “نانسي”، وعاد إلى دمشق، في استئناف لرحلاته المكّوكية.
الشاعر يوسف عبيد نظم قصيدة بعنوان “شهر العسل”، على أنه لزيارة كسينجر هذه، بصحبة عروسه. ابتدأ الشاعر قصيدته واصفاً العروس وعروسه:
شربَ المُدامةَ وانثنى نشوانَ مغـرور الأمــاني
واختال فوق الريح في سبّاقةٍ كالبرق جامحةَ العِنان
وعروسُهُ الحسناء في صَلَـفٍ تتيـه بعُنفـــوانِ
والخنجر المسـموم في يـده كَنَـابِ الأُفعــوان
وحقائبُ الدولارِ مُثقلةٌ فِصاحَ النطق، ساحرة البيان
يُلْقَى بها ثمناً لمأجورٍ صغيرِ النفس خَوَّانٍ جبــانِ
فلتبرزِ الأوطانُ هاتفةً مُرَحِّبَةَ المرابع والمغانــي
بوزير أمريكا بِرَكْبِ عروسه الحسناءِ سيِّدةِ الغواني
وفي مقطعٍ آخر يخاطب رأس النظام:
يا مَنْ تسير وراء أمريكا ذليـل الـرأس، منقاد اللجـامِ
وترى الوسام الأجنبي بصدرك الخاوي فتفخر بالوسـام
وتَعَبُّ كأس الغدر خلف ستائر الإجرام، والجولان ظامي
لا تَحسَبِ الأوطان غافلةً عـن اللُّعَبِ المُدمِّرةِ الجسـامِ
وهكذا إلى آخر سبعين بيتاً.
ويبدو أنه ألقى هذه القصيدة في عدد من السهرات والتجمعات. فاعتقلته المخابرات، وسجنته في فرع مخابرات حلب، ثم في الحلبوني، ثم كان مستقرُّه في سجن حلب المركزي.
وفي كلِّ سجن من هذه السجون كان رؤساء هذه السجون، ومحقّقوها، وسجّانوها، وسجناؤها… يُعجبون بالقصيدة، ويلتذّون بسماعها، لكنَّهم لا يجرؤُون غالباً أن يُبْدوا إعجابهم بها وبقائلها، وشماتتهم بـ “بطل الجولان” فكانوا يحتالون لسماع القصيدة مرة تلو الأخرى.
ففي بداية الاعتقال استمع المحقق إلى القصيدة كاملةً من الشاعر، وبعد ذلك قال كلاماً يلوم فيه ذلك الشاعر لَوْماً رسمياً!. يقصُّ أبو ضياء علينا قصة جلوسه أمام هذا المحقق:
وجلسـتُ فـي صمـتٍ وألـقى بالسـؤال: أَأَنـتَ شاعـــر؟!
ومتى نظمتَ الشعرَ، أوَ ما علمتَ بأنَّ نظم الشعر من إحدى الكبائر؟
ولـمَ الهجــاءُ المـرُّ للأسـد الهمـام، وعَدْلُه كالشمس ظاهـر؟!
وإذا تطـاول شاعـرٌ يهجـوه، فالمذيـاعُ يُخْـرس كـلَّ شاعــر.
وهكذا في قصيدة جديدة، يردُّ فيها على المحقّق “الموظف”.
وفي الحلبوني كذلك، كان يأتي عنصر المخابرات، من سجّانٍ أو محقّق، أو رئيس حَرَس… فيقول: هل صحيح يا أبا ضياء أنك نظمت قصيدة في هجاء الرئيس؟! فيقول: نعم. فيقول: هل يمكن أن تسمعنا إياها؟!.. فيسمعه إياها كاملة.
يذهب هذا “العنصر” ثم يعود ومعه عنصر آخر أو اثنان، ويطلب من أبي ضياء أن يُسمع القصيدة ثانية.
ثم يأتي عنصر آخر فيكرر القصة. وكلهم يبدي سروره وإعجابه! فتصوّروا.
بل إننا، في سجن حلب المركزي، شاهدنا موقفاً أعجب. ففي أمسية أحد الأيام، كان يمرّ أمام السجن قائد شرطة محافظة حلب، ومعه “النائب العام” وبدا لهما أن يزورا ذلك السجن. واستقبلهما الضابط المناوب النقيب نهاد شقيفة، وراح الثلاثة يتجولون في ردهات السجن. فلما مرّوا أمام غرفتنا توقفوا، وتعرّفوا بنا وبقضايانا, وكان منظر أبي ضياء لافتاً للانتباه، فهو سجين سياسي ضرير! سأله قائد الشرطة: ما قضيتك؟. قال: قلتُ قصيدة في هجاء الرئيس!. قال: هل تسمعنا إياها؟! قال: نعم. وبدأ ينشد قصيدته. وكنتُ أنظر في وجوه الثلاثة: النقيب والضيفين، فأرى مظاهر الفرح والإعجاب.
وبعد ذهابهم. عاد إلينا النقيب فقال: إنَّ السيد رئيس شرطة المحافظة يطلب نسخة من القصيدة!!!.
* * *

وأختم هذا الحديث عن الشاعر أبي ضياء، فأقول: لكل شاعر أبيات يقولها تندّراً وتملُّحاً، وتكون في الغالب بِنت لحظتها، وهي، وإن لم تكن في مستوى الشعر العالي الذي ينسب إليه، تعبِّر عن مشاعره العفويّة.
مرّة كان يتناقش مع أحد البعثيين، فقال البعثي: شعارنا: أمة عربية واحدة. ذات رسالة خالدة. فسأله أبو ضياء: وما تعريف الشعار؟! فارتبك. وبعد ذهابه قلت: أتسأله عن التعريف، والتعريفات يعجز عنها من هو أكثر علماً وثقافة منه، بل لعلَّ هذا “الرفيق” لا يفرِّق بين الشعير والشعار؟! فضحك وقال:
الشِّعر والشعير والشعار يحسبها سواءً الحمارُ
———-
ومرة، فقد نعليه من مكانهما. وهو يسمي النعلين “كُلاشاً” فقلت له: خُذْ أيَّ كُلاش من كلاشاتنا! فقال:
إذا ذهب الكُلاش فلا كلاشٌ يقومُ مقامهُ عند اللَّبـوس
كان شِراكَهُ لمســاتُ خَزٍّ كأنَّ مَدَاسَهُ وجه الرئيس!.
———-
وقد قضينا في السجن معاً ما يزيد على السنة، فكانت روح أبي ضياء الحلوة تُذهب أكدار السجن، وتضفي عليه سروراً وحبوراً.
رحمه الله رحمةً واسعة، فقد علمت أنه توفي في صبيحة يوم الأربعاء 24/10/1427هـ- 15/11/2006م.
وهو من مواليد قريته (عين النخيل) عام 1931م.
 أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد
أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد




